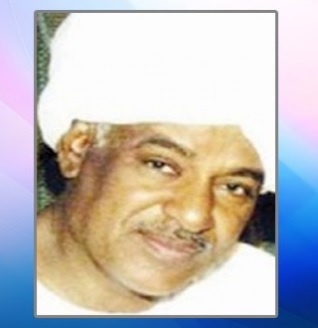الشيوعيون والإسلاميون: كيف تكون الثنائيات قاتلة؟

سألني أحد الأصدقاء ألا ترى أنَّ أزمة السودان تكمن في الثنائيات القاتلة؟ فسألته ما المقصود بالثنائيات القاتلة؟ فرد قائلاً: جهوياً ثنائية الشمال والجنوب، وطائفياً ثنائية الختمية والانصار، وأيديولوجياً ثنائية الشيوعيين والإسلاميين. ثم سألته لماذا سميتها قاتلة؟ هل ذلك اقتباساً من كتاب أمين معلوف الموسوم بـ “الهويات القاتلة”؟ فرد عليَّ قائلاً: ليس اقتباساً من معلوف، لكن من واقعنا السياسي المعيش، الذي يقدم المصلحة الجهوية، أو الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية العامة.
انظر لواقع الساحة السياسية الآن بعد أن انجزنا ثورة عملاقة، اشتركت فيها كل شرائح المجتمع السوداني، هل تجد رؤية وطنية جامعة لحل مشكلات السودان، أم صراعاً سياسياً تحركه الدوافع الحزبية الضيقة ومصالح النخب الشخصية؟ اتفق مع فرضياتك يا صديقي، لكن دعني أذهب إلى القول بأن الشيوعيين والإسلاميين هم بورة القوى السياسية الحديثة في السودان، ويستند أعضاء كل فريق إلى طيف من الأيديولوجيات المتعارضة مع بعضها، لكنها إذا اتخذت من المصلحة الوطنية العامة مرجعية لها، ربما تجد بعض المشتركات المهمة، التي يمكن أن تُوظف في معالجة كثير من مشكلات السودان المزمنة، بشرط أن تُنقل مقومات المصلحة الوطنية العامة إلى المركز، وتُحول نقاط الخلاف الأيديولوجي إلى الهامش الذي يسمح بسماع الرأي والرأي الآخر؛ لأن السودان في الأساس يحتاج إلى دولة خدمية، تنظر في قضايا الفقر (الاقتصاد) والجهل (التعليم) والمرض (الصحة).
لكن إذا غابت الرؤية الوطنية الجامعة عن أجندة الطرفين، وقدم كل طرف كسبه الحزبي الضيق على حساب المصلحة الوطنية الواسعة، تتحول هذه الثنائيات الأيديولوجية-السياسية من ثنائيات فاعلة في البناء والتعمير إلى ثنائيات قاتلة، كما ذكرت أيها الصديق. وعند هذا المنعطف يتضخم الخلاف الأيديولوجي الذي لا تحكمه معايير أخلاقية، وتتعاظم إشكالية “الأنا” و”الآخر”، التي تبعد الطرفين عن الممارسة النقدية، التي تروم عِتْق الذات من أوهام التمركز حول نفسها، وهوس التفوّق، والأفضلية المفترضة، وبذلك تتضاءل فرص التوافق في حل القضايا الوطنية، وتقل أمكانيات التحرر من التخيلات الوهمية، وفكّ الالتباس القائم على علاقة غير سليمة مع الآخر. ويؤدي ذلك، يا صديقي، إلى ظهور الكراهيات غير المبررة التي تتحول إلى حالات شبه مرضية، تضخ موجات من التوتر، التي ترفع سقف النقد الموجه للآخر، دون النظر في مشكلات الأنا، وبذلك تبعد عن طرح الحلول الممكنة لمشكلات البلاد والعباد، وينحدر الانحطاط السياسي إلى القاع، ويظل الماضي مستخدماً دوماً ضد مصلحة الحاضر واستشراف المستقبل.
وفي إطار هذا المشكل الثنائي المعقد، تبرز مشكلة أخرى داخل إطار النسق الفكري والسياسي الواحد، قوامها تبعية العضوية الحزبية الكاثرة إلى الأقلية المنظَّرة فكرياً وسياسياً، تبعية عمياء، حتى لو كانت الأكثرية تبوح بفشل الأقلية في مجالسها الخاصة. وهنا، يا صديقي، يحضرني السؤال الذي طرحته غاياتري سبيفاك (Gayatri Spivak) في سياق دراستها للعلاقة الجدلية بين المستعمِر والمستعمَر، والذي مفاده: “هل يستطيع التابع أن يتكلم؟”. حاولت أن أجد لهذا السؤال الافتراضي إجابةً في بعض منصات التواصل الاجتماعي لناشطين شيوعيين وإسلاميين. وتبين لي بعد الاطلاع عليها أن مشكلة التبعية وغياب الرؤية الوطنية الحاكمة لتفكير كلاً من الطرفين، تشكلان أس الثنائية القاتلة.
ويظهر ذلك في عناوين بعض منصات التواصل الاجتماعية التي تعج بموضوعات ذات حمولات أيديولوجية غير منتجة، ونذكر منها على سبيل: “الحقيقة: إنّ الدّيموقراطيّة، واللّيبراليّة، والعلمانيّة، والتّنويريّة، والدّولة المدنيّة… كلّها تنازع الإسلام في أصوله وفروعه وأخلاقه، وتعاملاته، لا يجمعها به أيّ رباط، تماماً كالتّناقض بين الكفر والإيمان!” وللأسف توجد مثل هذه العبارات في مواقع بعض الناشطين الإسلاميين الذين ينادون بالحرية والعدالة والسلام.
دون أن يقدموا نقداً داخلياً وموضوعياً لاطروحاتهم الفكرية، ولمؤسساتهم الحزبية التي ساندت حكومة الإنقاذ ثلاثين عاماً، ولرموز الإنقاذ الذين أفسدوا الحياة العامة في السودان، بل على العكس يروج بعضهم لموضوعات تؤكد تجذر التباغض السياسي وتعمق المكابرة، مثل “هذه الحكومة الفاشلة يجب أن تذهب بحمدوكها”؛ “ديموقراطيّاً: هل كان على لوط (عليه السّلام) قبول رذيلة قومه، كونهم يشكلون غالبية المجتمع!!”. فلا عجب في أن مثل هذه المقولات والافتراضات وغيرها فيها قدح صريح للديمقراطية التي تعتبر أفضل الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة التدافع السياسي، والتي رفعها ثوار ثورة ديسمبر شعاراً لتحقيق تطلعاتهم السياسية.
وعلى الضفة الأخرى من النهر ترفع شعارات مثيرة للخصومة السياسية، “أي كوز ندسوا دوس”، فضلاً عن إعلاء صوت لجنة تفكيك حكومة الثلاثيين من يونيو على حساب أولويات المرحلة الانتقالية الأخرى، مثل السلام الشامل، والعدالة الانتقالية، وإكمال هياكل الحكم الانتقالية (تعيين الولاة، وتشكل المجلس التشريعي)، وتشكيل المفوضيات ذات الصلة بالفترة الانتقال الديمقراطي، مثل مفوضية الإعداد للمؤتمر الدستوري، ومفوضية الانتخابات العامة. ولذلك كان من المفترض أن تسير هذه الأولويات في خطوط متوازية، بهدف تحقيق استحقاقات الفترة الانتقالية، وانتقال النخبة السياسية من مربع السياسة إلى مربع السياسات الراسمة لمستقبل السودان والانتقال الديمقراطي المنشود.
يجب أن تعلم يا صديقي، إنني لا أرفض الأيديولوجيات في سياقها العام؛ لأنها مجموعة من الأفكار والقيم لها أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها؛ وبذلك تصبح من مكونات الثقافة في كل مجتمع، لكنها لا تستغرق الثقافة كلها، بل تشكل الناتج الفكري لبعض طبقات المجتمع، فأحياناً تكون ذات طابع محلي، وأحياناً تكون عابرة للقارات، وهنا تأتي عملية الفرق بين التطبيق الحرفي، والتطبيق الذي يستوعب متطلبات البيئات المحلية، التي تختلف تضاريسها السياسية والاجتماعية والاقتصادية عن تضاريس البيئات التي نشأت فيها مثل هذه الأيديولوجيات من حيث الزمان أو المكان.
لكن، يا صديقي، عندما انتقد الصراع الأيديولوجي الحزبي في السودان، أقرن استخدام المصطلح بالحمولات الأيديولوجية، أو الإسقاطات الأيديولوجية؛ لأنها من وجهة نظري تكون في شكل قيم وأفكار جامدة، تتبناها جماعات محلية، فتؤثر في منطلقاتها السياسية، وتجعلها ترى الأشياء تبعًا لمنطقها لا منطق الأشياء نفسها؛ وهنا تتحول الاسقاطات الأيديولوجية إلى معرفة قطاعية، تتسم بالجمود، غرضها الأساس إنجاز فعل اجتماعي يحقق مصلحة المجموعة المعنية بالأمر دون النظر إلى المصلحة الكلية للناس أجمعين، والظروف الموضوعية التي تحكم الواقع المعيش.
وعند هذا المنعطف يتصدَّر المشهد السياسي سؤال مَنْ يحكم السودان بدلاً عن سؤال كيف يحكم السودان؟ وترتبط أهداف التغيير بالشكلي دون الموضوعي؛ وتقدس القيادات الحزبية دون النظر في إسهاماتها الفكرية والسياسية، وتُبنى الأصنام السياسية التي تُعبد دون التفحص في عطائها الوطني، ولذلك عانى السودان كثيراً في إسقاطات الثنائيات القاتلة، والدليل على ذلك فشل أحزاب الحركة الوطنية في تأسيس نظام حكم ديمقراطي مستدام، وانفصال جنوب السودان، وسياسات التأميم والتطهير التي مارسها نظام نميري (1969-1985م) في بادئ عهده الأول، وإسقاطات المشروع الحضاري وسياسة التمكين التي تبناها النظام المباد (1989-2019م)، ولا تزال تقف حجرة عثرة في طريق ثورة ديسمبر 2018م، وتحقيق أهدافها المنشودة.
وفوق هذا وذاك، يا صديقي، لو أمعن النظر، نلحظ أن مشكلات السودان الرئيسة تتبلور في ثلاثية الجهل والفقر والمرض؛ هل قدمت هذه الحمولات الأيديولوجيات حلولاً موضوعية لهذه المشكلات الأساسية؟ نعم تكتنز الأيديولوجيات قيماً إيجابية كثيرة، وبينها مشتركات وإن اختلف منصات تأسيسها؛ لكن التحدي الأساس يتمثل في كيفية توظيفها على أرض الواقع، فالأمور لا تقاس برغائبها السياسية، ولكن بمخرجاتها المحسوسة للناس أجمعين.
أحمد إبراهيم أبوشوك
صحيفة السوداني