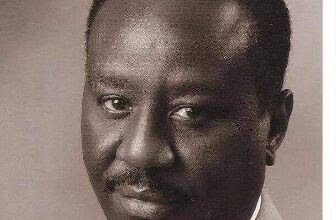التجاني عبد القادر: الثورة السودانية والبرجوازيون الصغار

في محاولة لتفسير ظاهرة “الثورة”، اعتاد المؤرخون طرح هذه الأسئلة الثلاثة: من يقوم بالثورة، وضد من تقوم الثورة، ولمصلحة من؟ وحيث أن الثورة الفرنسية كانت أبلغ أثرًا فقد صارت أوفر حظاً في الدراسة، وكانت الخلاصة التي انتهى إليها كثير من المؤرخين هي أن الثورة الفرنسية قد قام بها “البرجوازيون”، وأنها كانت ثورة ضد الاقطاعيين والارستقراطيين، وأنها كانت لمصلحة الطبقة البرجوازية ذاتها، والتي لم تعمل بعد نجاح الثورة إلا على تعزيز الملكيات الخاصة، وإزاحة الحواجز والنظم التي كانت تقيد حريتها في التجارة، متجهة بالبلاد في طريق التطور الرأسمالي. ثم صارت هذه الخلاصة ذات المنطلق الماركسي “وصفة” عامة تقاس عليها الثورات الأخرى. فذهب بعضهم، عطفاً على هذه الرؤية، يدرجون ثورة يوليو 1952 الناصرية في هذا الإطار، فيقولون إنها كانت موجهة ضد طبقة الاقطاع (الباشوات وكبار الملاك الذين كانوا يحتكرون الأراضي الزراعية)، وإن المستفيد منها هم الفلاحون والشرائح الريفية الضعيفة في المجتمع المصري، غير أن قيادة الثورة الناصرية كانت، بحسب هذه الرؤية، تنتسب إلى “البرجوازية الصغيرة”، مما أفقدها “الشرعية الطبقية” للقيادة، وذلك وفقاً للتفسير الماركسي الذي يشدد على حتمية قيادة “الطبقة العاملة” لأي تحرك ثوري اشتراكي. أما في حالة الثورات الأخرى حيث لم يوجد إقطاع أو باشوات (كحالة السودان مثلا)، فضد من قامت الثورة؟ ومن قام بها؟ أهي الطبقة العاملة أم البرجوازيون الصغار؟ ولمصلحة من؟ إن طرح هذه الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها سيجعلنا نتحول قليلاً من حالة الانبهار العاطفي بالثورة إلى حالة من التعقل والتدبر في طبيعتها ومآلها.
لم يجد مفهوم “الطبقة” رواجاً في أدبيات السياسة السودانية، وربما يعود ذلك لما اتسم به السودان من سيولة اجتماعية يصعب معها التقسيم إلى طبقات اجتماعية صلبة، غير أن ذلك لا ينفى وجود تمايزات بين المواطنين، كما لا ينفى وجود “نخب” متجانسة في الثقافة، ومتقاربة في المصالح. ولهذا فقد اعتاد السياسيون والإعلاميون، منذ ثورة أكتوبر 1964، على استخدام مصطلحي “القطاع الحديث” و”القوى الحديثة”، وهما مصطلحان فضفاضان يقصد بهما مؤسسات ما بعد الاستعمار ومن يشغلها من التكنوقراط؛ أي فئات المتعلمين والمهنيين الذين تخرجوا في الجامعات والمعاهد العليا، فصار لهم (بحكم تأهيلهم العلمي والمهني) تأثير كبير نسبياً على مؤسسات الدولة وعلى الكيفية التي توضع بها سياساتها و تنفذ، كما صار لهم دور كبير في صناعة “فضاء” يتم فيه توجيه الرأي العام ليتقبل تلك السياسات فيدافع عنها، أو يرفضها ويعرقل مسارها. ولم تكن شريحة التكنوقراط تسير دولاب الدولة في فراغ، وإنما كانت تحيط بها نخب من “رجال الأعمال” تستثمر في السلع الاستراتيجية، وتهيمن بالتالي على قطاعات الاقتصاد، مستفيدة من قوانين الاستثمار ونظم التصدير والاستيراد. وبهذه الطريقة أستطاع مركب “القطاع الحديث” أن يبرم تحالفاته، وأن يوجد لنفسه ما يشبه حق “الفيتو” في الإمساك بأجهزة الدولة، والتحكم في السلطة والثروة (في مقابل المجتمع التقليدي العريض).
ويرى السيد إبراهيم منعم منصور، وزير المالية الأسبق، أن هناك بعداً “خارجياً” داعماً لمركب القطاع الحديث في السودان، يتمثل في المؤسسات المالية الغربية، ويأتي على رأسها البنك الدولي الذي جعل من مسلماته أن “القطاع الحديث” هو القاطرة التي تقود الاقتصاد السوداني، على عكس “القطاع التقليدي” الذي يتسم بالركود. وسواء كانت هذه الفلسفة نابعة من قناعة فكرية، أو من مصلحة تجارية تتعلق بتسويق المعدات والمواد التي تنتجها الدول الصناعية المتقدمة، فإنها قد أدت في النهاية، بحسب الوزير، إلى اتساع الهوة بين وسط السودان وأطرافه، مما زاد شعور المواطن في الهامش بالظلم والعداء الخفي للمركز (1).
وهذه ملاحظة صائبة، ويمكن أن يضاف إليها أن هذه “القوى الحديثة” لم تكن قادرة (وإن دعمها البنك الدولي) على التوجه الصادق نحو عمليات الإنتاج فتحدث الطفرة التنموية المطلوبة، كما لم تكن قادرة من ناحية أخرى على إحداث طفرة في السياسة عن طريق الوسائل الديموقراطية القائمة على التفويض الشعبي، إذ كان التأييد الشعبي يذهب تلقائيا إلى “النخب التقليدية”؛ أي قيادة الأحزاب السياسية الكبرى ذات الولاء الطائفي الأعمق، والانتشار الجماهيري الأوسع. وبإزاء هذا المأزق عادة ما كانت تلجأ بعض شرائح القوى الحديثة (من ذوي الطموح السياسي والنظر الأيديولوجي) إما إلى الاستقواء بالمؤسسة العسكرية، وفرض نوع من الهيمنة على الدولة والمجتمع معا، أو إلى إنشاء “مليشيات” مسلحة تنهش في عظم الدولة؛ مما أدخل البلاد في الحالة الراهنة التي نعيشها؛ من صراع سياسي عقيم حول الدولة، وحروب أهلية لا تنقطع، وتخلف اقتصادي فاضح، وتمزق مريع في شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية.
ولكن، وبعد سلسلة من الانقلابات والانقلابات المضادة، أصبح دور هذه الشرائح من القطاع الحديث يتضاءل، ويعود هذا التضاؤل لأسباب كثيرة، منها أن القطاع العام في الدولة لم يعد جاذباً لأنه لم يعد مصدراً أساسياً للثروة أو الجاه بسبب التدهور الذي أصاب القطاع الزراعي والصناعي، وبسبب الحروب الأهلية المتطاولة في أطراف البلاد منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. يضاف إلى ذلك أن طفرة النفط في منطقة الخليج قد صارت أكثر جاذبية لأصحاب المهن والمهارات الخاصة (من معلمين وأطباء ومهندسين)، وترتب على ذلك أن نما وتطور قطاع حديث جديد، ولكن ليس في السودان وإنما في بلدان الاغتراب (السعودية ودول الخليج تحديداً). وقد ظلت هذه الفئة (التي تقدر بنحو من ثلاثة إلى خمسة ملايين) تتحصل على دخول عالية، فصارت لها قدرة شرائية كبيرة، وتأثير ملحوظ في الاقتصاد السوداني، سواء على مستوى الأسر أو الدولة أو المجتمع (تذهب بعض التقديرات إلى أن ما تكتسبه هذه الشريحة يساوى نحواً من 12 مليار دولار في العام).
وقد تبدى تأثير هذا الشريحة في قدرتها على إعادة إنتاج نفسها عبر مجالي التعليم والاقتصاد (خاصة المشاريع الصغيرة). إذ يلاحظ أن معظم فئات هذه الشريحة السودانية المهاجرة تحرص، مثلها في ذلك مثل رصفائها في العالم العربي، على الاستثمار في التعليم، (2) إذ تسعى لتوفير تعليم أفضل لأبنائها، فتلحقهم بالمدارس والكليات الخاصة عالية التكلفة لدراسة علوم الطب والهندسة والحاسوب والإدارة ونحوها، وتعد الطلاب للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية. وعلى مستوى التعليم المدرسي، تشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد الطلاب السودانيين المسجلين في مدارس خاصة أخذ يزداد بنسبة 8% في العام في الفترة ما بين 2001-2009، أما في عام 2012 فقد بلغت نسبة طلاب المدارس الخاصة الذين جلسوا لامتحان الشهادة السودانية نسبة 21% من جملة الطلاب؛ (3) مما يشير إلى رغبة أولياء الأمور (من هذه الشريحة) في التحول من مدارس الدولة إلى مدارسهم الخاصة (أي التي يديرها القطاع الخاص). أما إذا أضفنا إلى هذا عدد الأسر السودانية التي هاجرت إلى أوروبا والولايات المتحدة، وما توفر لأبنائها من تعليم، وما اكتسبوا من مهارات لغوية وتنظيمية، فسنجد أن جيلاً ثانياً من أبناء القطاع الحديث قد بدأ يتشكل ولكن خارج الأطر الاجتماعية التقليدية، وخارج الأطر الحزبية السائدة؛ وقد استطاع بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 أن ينال مكانة ملحوظة في دوائر الحكومة الانتقالية الراهنة.
أما من الناحية الاقتصادية فإن معظم أفراد هذه الشريحة يميلون لاستثمار الأموال التي حصلوا عليها إبان سنوات الهجرة في شراء العقار وفى مجال الصناعات والأعمال الصغيرة (تماما كما هو حال البرجوازية الصغيرة)، وقد جاء في بعض نتائج المسح الصناعي والخارطة الاستثمارية في السودان أن المشروعات الصغيرة تمثل نحوا من 90 % من مجمل الأنشطة الاقتصادية. ومما يساعد على ذلك أن السياسات الاقتصادية ظلت تتجه منذ سنوات خلت إلى تحرير الاقتصاد السوداني من التدخل الحكومي، وخصخصة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستخدام الحر.
ثم ازدادت الحظوظ الاقتصادية لهذه الشرائح مع ظهور النفط بكميات تجارية. إذ شهد السودان طفرة نفطية في الفترة ما بين (1999-2010)، حيث بلغت عائداته نحوا من 600 مليون دولار سنويا، وهو ما شكل 80% من صادرات السودان، ولكن ترافق مع ذلك تضاؤل مطرد في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، مما أحدث تغييرات كبيرة في التركيبة الاقتصادية والاجتماعية، فتبدلت طبيعة القوى العاملة في القطاع التقليدي (الزراعي والرعوي)، وظهرت مدن وأسواق جديدة في مناطق النفط، وتوسعت خطوط المياه والكهرباء، وازداد عدد المدارس والجامعات والمستشفيات، وارتفعت أسعار الأراضي. ولم يكن مستغرباً أن تظهر مع تلك الطفرة النفطية فئات رأسمالية ومجموعات مصالح، وأن تتمحور “اقتصاديا” حول قطاع النفط، كما تتمحور “سياسيا” حول الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني)؛ خاصة وأن ذلك الحزب كان يبحث، تحت وطأة الحصار الدولي، عن منافذ إلى الأسواق، وعن حاضنة اقتصادية تتمتع بالقبول لدى المؤسسات المالية الاقليمية والدولية، فانعقدت تبعا لذلك “شراكة الضرورة” بين شريحة سياسية حاكمة تبحث عن تأييد وولاء من خارج دائرتها، وشرائح من قوى رأسمالية غير منتمية للتوجهات الفكرية للحزب الحاكم ولكنها تتجاوب معه حرصاً على مصالحها الاقتصادية.
ولكن، وبقدر ما ساهمت تلك الشراكة المسمومة في إعطاء حكومة الإنقاذ نافذة على الخارج، فقد ساهمت أيضا في انهاكها والقضاء عليها. فما أن انفصل الجنوب في عام 2011، وآلت معظم الحقول النفطية إليه، إلا وقد دخلت البلاد في صدمة نفطية ماحقة لمدة سبعة أو ثمانية أعوام (2011-2019). وهي الصدمة النفطية التي مهدت لثورة ديسمبر 2018؛ حيث فقدت الدولة 20% من أراضيها و70% من مواردها، و50% من ميزانيتها العامة، مما جعلها تتخذ إجراءات متشددة لجمع المال عن طريق الضرائب والرسوم المتنوعة، أو عن طريق رفع الدعم عن السلع، مع التوسع في منصرفات الدولة. ولم تجد أمامها بالطبع مورد للعملة الصعبة غير مدخرات المغتربين ورجال الأعمال. ولكن هذه الشريحة بدأت تقبض يدها، إذ تشير تقارير بنك السودان المركزي أن حجم تحويلات المغتربين لعام 2018 لم تتجاوز 211 مليون دولار عبر النظام المصرفي. وهو مبلغ في غاية الضآلة إذا ما قورن بالكتلة النقدية للسودانيين العاملين بالخارج التي كانت تقدر بنحو 6 مليار دولار. وازدهر في تلك الحالة السوق الموازي للعملات الأجنبية، حيث قدرت الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي بنحو 354 مليار جنيه. وانخفض بالطبع سعر العملة المحلية، وزادت تكلفة الإنتاج فتقلصت قيمة الصادرات السودانية، واختل ميزان المدفوعات ودخلت البلاد في ضائقة اقتصادية وسياسية أصابت شريحة البرجوازيين والرأسماليين بالهلع. وتحدثت بعض التقارير الصحافية أن الاستثمار الوطني قد “هرب” في تلك السنوات إلى اثيوبيا، ويذكر أن حجم استثمار السودانيين هناك قد بلغ نحوا من 3.4 مليار دولار، وأنهم أقاموا نحوا من 300 مشروع استثماري ليحتلوا المرتبة الثانية بعد الصين. وفى ظاهرة أخرى ملفتة للأنظار بدأت عشرات الأسر من المغتربين السودانيين المقيمين بدول الخليج تتجه نحو القاهرة والإسكندرية لتشتري عقارات سكنية هناك، وصارت كثير من الأسر تفضل قضاء العطلات مع أبنائهم في المدن المصرية وليس في الخرطوم. (4)
وهكذا يمكنك أن تلاحظ أن فئات من القوى السودانية الحديثة تستطيع أن تحافظ على وجودها في كل الظروف، سواء عن طريق الهجرة إلى دول الخليج، أو عن طريق الاستثمار في العقار والصناعات الصغيرة؛ وأنها تستطيع بالتالي أن تعيد انتاج نفسها في الجيل الثاني من أبنائها. وقد جاء ظهور هذا الجيل نتيجة لثلاثة عوامل متداخلة: إعداد علمي ومهني خارج إطار مؤسسة التعليم السودانية وأفضل، واستقلال اقتصادي نسبي عن الدولة السودانية، وقدرة عالية على الاستفادة من ثورة المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتقنية التواصل الالكتروني الحديث. وهذه شريحة قليلة العدد، ولكن ما يميزها عن القوى الحديثة السابقة هو قدرتها على التواصل والحركة والمشاركة الفعالة، فهي ليست مجرد شريحة متلقية تستنزل الألعاب العنيفة والفنون الهابطة وتستهلكها، كما كان يُظن، وإنما هي شريحة فاعلة تنتج مادة سياسية وتحملها على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، فتصنع لها جمهوراً يقدر بمئات الالاف. ويمكننا أن نشير في هذا الصدد للدور الذي لعبته هذه الشريحة إبّان تفاقم مشكلة دار فور (2005-2010)، وكيف أنها استطاعت أن تتماهى مع تيارات الرأي العام العالمي، وأن تبلور تياراً قوياً مناوئاً لسياسات الحكومة ولقياداتها. كما يمكننا أن نشير أيضا لدورها في انتفاضة سبتمبر 2013، التي فاجأت الحكومة والمعارضة معا، أو لتجربة “نفير” التي أطلقها مجموعة من الشباب في خريف عام 2013 لمواجهة أزمة السيول والفيضانات في ولاية الخرطوم، حيث استطاعت تلك المجموعة “المجهولة” لدى الجهات الرسمية أن تنال ثقة كبيرة من الجمهور، وأن تتلقى من ثم تبرعات كبيرة، وأن تقوم بتوزيعها على المحتاجين بدقة وإحكام، متفوقة في ذلك على الأجهزة الحكومية الرسمية. ثم تبلورت هذه الروافد الشبابية لترمي بثقلها في ثورة ديسمبر 2019 التي أطاحت أخيراً بنظام الإنقاذ.
كل هذه أمثلة حية تشير إلى أن فاعلاً جديداً قد دخل الساحة السياسية وتحته “وسادة” أبوية يتكئ عليها، ولكن المفارقة أنه بدأ يخرج عن الإطار الأبوي وينتهج أسلوباً يميل إلى “تجاوز” المؤسسات الحزبية والاعلامية الكبرى، ويحجم عن الهرمية القيادية والولاءات العشائرية والايديولوجية الثابتة. أما هل يستمر مثل هذا التجاوز والاستقلال، أم أنه سيسير في اتجاه التماهي مع شريحة رجال الأعمال ومجموعات المصالح الرأسمالية، كما فعل الجيل السابق، فذلك موضع تساؤل؛ ولكن احتمال “التماهي” هو الأقرب، خاصة وأن هناك بالفعل عدداً ملحوظاً من كبار المسئولين في الحكومة الانتقالية الراهنة، والتي تشكلت بموجب شرعية الثورة، كانوا ولا يزالون على صلات قوية بدوائر الرأسمالية المحلية؛ بل أن بعضهم كانوا موظفين لديها.
وإذا صح هذا فإن الموجة الأولى من “الثورة السودانية” يكون قد تم اختطافها، ليتولى قيادتها رجال الأعمال والبرجوازيون الصغار الذين يميلون بحكم مصالحهم وثقافتهم وطموحاتهم نحو “الليبرالية الجديدة” التي لا تسعى لتطور ديموقراطي بقدر ما تسعى لتحقيق أرباحها، حتى ولو اقتضى ذلك تعويم العملة المحلية، والتخلص من مؤسسات القطاع العام، وإيقاف الدعم الاجتماعي، والانصياع الكامل للخارج، بقطع النظر عما يحدث للطبقة العاملة القديمة، ولنقاباتها واتحاداتها، وللعمال اليدويين والفلاحين التقليديين. غير أن هذا مسار سيمهد الطريق لا محالة لموجة ثانية من الثورة قد يقودها هذه المرة القطاع “التقليدي” في تحالف مع القطاع الحديث الأكثر فقراً.
ومما يجدر بالذكر أن الشريحة الشبابية الحديثة “المستقرة” ذات “المجد الأبوي”، والتي أشرنا إليها آنفاً، لا تمثل كل قطاع الشباب. إذ يوجد نقيض مقابل لها في الداخل المحلى يمكن أن يسمى “الشرائح الوسطى الفقيرة”، والتي تضم المتعلمين الذين يقفون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل. فهؤلاء لا يتطلع أحدهم لأكثر من وظيفة مناسبة، توفر له دخلاً سنوياً مناسباً، فيتمكن من زيجة متواضعة، ومن المحافظة على أسرته الصغيرة، وأن يتمكن من العلاج إذا أصابه مرض. وهؤلاء يمثلون كماً كبيراً من الشباب تخرج في الجامعات السودانية، ولكنه لم يجد فرصة للعمل في القطاع الخاص أو العام، كما لم يجد فرصة للهجرة إلى دول الخليج، فظل يتحمل لفترات طويلة معاناة البطالة، ويحس يومياً بالعجز الاقتصادي، وبالصغار الاجتماعي، والإحباط النفسي، خاصة حينما يرى رصفاءه يصلون بيسر إلى شبكات الدعم، أو يصعدون السلالم السياسية والاقتصادية اعتماداً على روابطهم العائلية والمناطقية.
وقد استطاعت عناصر من هذه الفئة أن تتجه نحو مناطق تعدين الذهب، كما اتجه بعضها نحو تنظيمات المجتمع المدني، خاصة وأنه قد نشأ في السودان قطاع جديد إلى جانب القطاعات الاقتصادية المعروفة هو “قطاع المنظمات غير الحكومية”، وهو قطاع يعتمد على التمويل الخارجي، مما أتاح له قدرة توظيفية كبيرة. وقد بلغ عدد المنظمات غير الحكومية نحوا من 59 منظمة في عام 2019، وتعمل جميعها في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، وتوظف عدداً كبيراً من العمال والموظفين السودانيين. على أنه إلى جانب هذه المجموعات الشبابية السلمية الساخطة لابد من الإشارة إلى شباب “المعسكرات” في أقاليم النزاع، فهذه مجموعات تعرضت لنيران الحروب والتشرد والحرمان، فاتجهت نحو أيديولوجية الهويات الاثنية، وصارت أكثر راديكالية حيث انضم معظمها إلى الحركات المسلحة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة وبعض مناطق الشرق(5). فكل هذه مجموعات شبابية فقيرة و”ساخطة”، وقد ساندت ثورة ديسمبر بقوة لأنها كانت تظن أن شعار “حرية سلام وعدالة” الذي هتفت به سيؤدي إلى تحسن في أوضاعها الاقتصادية، وإلى نصيب أكبر في السلطة السياسية (قريبا مما نصت عليه اتفاقية سلام جوبا). أما إذا ظل الوضع الاقتصادي على ما هو عليه من سوء، أو ظلت الحكومة الانتقالية تتماطل في تنفيذ ما التزمت به من عهود، فإن اندفاع هذه الفئات في موجة ثانية من الثورة قد لا يكون بعيداً.
خلاصات:
1- دبلوماسياً:لا شك أن السودان يحتاج في الفترة الراهنة إلى مساعدات من الخارج (الاقليمي والعالمي)، ولكن (الخارج) يحتاج أيضا إلى السودان؛ فالحاجة متبادلة. فإذا كان السودان يحتاج إلى الخبز والوقود فهم يحتاجون إلى المياه، وإلى القوة البشرية، وإلى الموانئ الجوية والبحرية، وإلى الأراضي وإلى المعادن، وكل ذلك يوجد في السودان. ما ينقص السودان هو القيادة القادرة على التفاوض “الفعال”؛ ولكن التفاوض الفعال مع الخارج لا يتم بدون “وحدة وطنية” في الداخل. إذ أن تفاوضك مع القوى الخارجية بحكومة انتقالية منقسمة على نفسها، وليس لديها ما يكفي من الخبز والوقود لمدة ثلاثة أشهر، يختلف كثيراً عن تفاوضك مع الخارج بحكومة تستند على إجماع وطني قادر على الصمود، ومؤسسة عسكرية قادرة على الدفاع.
2- اقتصادياً:لا شك أن السودان يمتلك ثروة كبيرة من الذهب، ويقدر انتاجه من هذه السلعة بنحو من مائة طن في العام بحسب الأرقام المعلنة. وقد تطور النشاط في هذا القطاع من التعدين التقليدي إلى عمل تجار ضخم. ولكن وكما تمحورت الشرائح الرأسمالية إبان فترة الإنقاذ حول قطاع النفط، فها هي الآن تتمحور حول قطاع الذهب؛ حيث ظهرت شركات خاصة ذات قدرات فنية عالية، ومهارات في التلاعب بالقوانين والمعلومات، وإصرار على تهريب السلعة إلى خارج الحدود. ويقدر عدد الشركات العاملة في هذا القطاع ببضع مئات، ويعمل فيها نحو من ثلاثة مليون سوداني أو أكثر (6). فاذا ظلت الحكومة ترتمي في أحضان (شركات الامتياز)، وتعجز عن مراقبة شروط التنقيب عن الذهب وتصديره، وعن وضع ضمانات كافية لتوريد نسبة من حصيلة الصادرات إلى البنوك المحلية، فستجد نفسها في المكان ذاته الذي كانت عليه حكومة الإنقاذ في أيامها الأخيرة.
3- استراتيجياً: لا يوجد تناقض جوهري بين المكون العسكري والمدني والبرجوازية التجارية في الحكومة الانتقالية الراهنة. وإذا كان هناك من يظن أن تحويل الشركات العسكرية والأمنية إلى الحكومة المدنية يعنى الدفع في اتجاه التطور الديموقراطي، أو في صناعة “سودان جديد”، فعليه أن يعيد قراءة “التفاهمات” (الإماراتية الإسرائيلية السودانية الأمريكية) الجارية. أما مجموعات اليسار (الشيوعي- البعثي) التي تملكتها الفرحة بما تحقق لها من إزاحة الإسلاميين، ومن تَمَكُن في هياكل الدولة، فستجد نفسها أمام خيارين: إما أن تنخرط في مسار “الليبرالية الجديدة” الذي انخرط فيه الآخرون، (بمساندة إقليمية ودولية)، أو أن تبقى في قارعة الطريق؛ مثلها مثل رموز الإنقاذ وعمال السكة حديد ومزارعي الجزيرة والمناقل.
4- ثورياً: إذا كانت الموجة الثانية من الثورة قادمة لا محالة، فلا ينبغي أن يكون اعتمادها على وضع المتاريس واحتلال الميادين وحسب، وإنما ينبغي أن يمهد لها بمراجعات أمينة للتجربة السابقة، وبإعادة تركيب الاستراتيجية للثورة الجديدة، وإعادة تشكيل لتضامن وطني جديد يجسر الهوة بين القطاعين: الحديث والتقليدي، وينظر للتنمية السياسية والاقتصادية من “الداخل” السوداني وليس من الخارج الدولي.
الهوامش والإحالات:
(1) إبراهيم منعم منصور في: إبراهيم محمد سليمان، معايير توزيع الثروة في السودان (الخرطوم: جامعة الخرطوم، مركز أبحاث السلام، 2012)، ص8.
(2) أنظر مثلا الحلة الفلسطينية في: جميل هلال، الطبقة الوسطى الفلسطينية (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2006)، ص 75.
(3) ويلاحظ أن 80% من هذه المدارس الخاصة توجد في ولايتي الخرطوم والجزيرة، ولتفاصيل أوفى أنظر تقرير اليونسكو لعام 2018 (UNESCO, Sudan: Education Policy, March 2018).
(4) أنظر مثلا صحيفة “الراكوبة” الالكترونية، 26 مارس 2020.
(5) د. حسن حاج على في: مجموعة مؤلفين، الشباب والانتقال الديموقراطي في البلدان العربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019.
(6) أنظر تحقيق الجزيرة (ميدان) بعنوان: من يسرق الذهب في السودان، 9 أكتوبر 2019، وأنظر كذلك تقرير صحيفة الشرق الوسط، 11 يناير 2020 بعنوان الذهب في السودان
التجاني عبد القادر حامد
أفريكا فوكس، العدد رقم (٣) فبراير ٢٠٢١،
الصادرة عن المركز الإفريقي للاستشارات