البرجوازية السودانية وصناعة الشماعة التاريخية
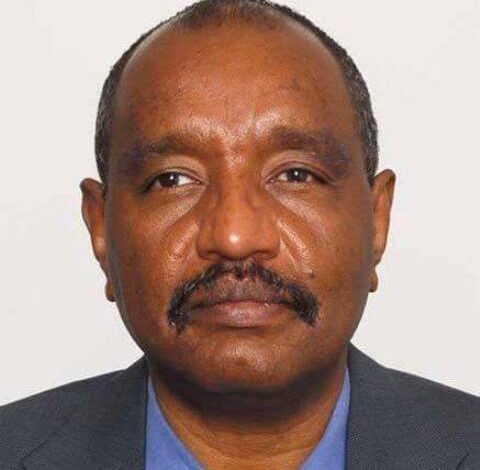
لقد قدَّم عمر البشير وثلاثون عامًا من حكمه للطبقة الوسطى السودانية المتعلمة حلاً سحريًا لمأزقها الفكري والأخلاقي والنفسي. فالعنف الصارخ الذي مارسه نظام الإخوان، خاصة في عقدهِ الأول، أتاح لهذه الطبقة أن ترمي كل إخفاقاتها وعيوبها الشخصية والوطنية على عاتقهم. وبإلقاء اللوم عليهم في كل فشلٍ وكل كارثة، برَّأت النخبةُ نفسَها من أي تقصير أو خللٍ أخلاقي أو فكري. وهكذا، أصبحت في نظر نفسها: طبقةً نبيلةً، مثقفةً، وطنيةً، متحضرةً، عادلةً، منزَّهةً عن الخطأ، بينما انحصر دور “صناعة الخراب” – بحسب روايتها – في الإخوان وحدهم. وكان هذا التفسير حلوا بدرجة مضاعفة لأنه أعفي النخبة من صعوبة التفكير العميق في المشاكل المعقدة التي يواجهها السودان.
كان مأزق البرجوازية السودانية في منافي الغرب واضحاً: فقد حمّلت أطفالها أساطيرَ عن “عظمة الشعب السوداني” (وهي عظمةٌ حقيقيةٌ بلا شكّ، نشاركهم الإيمان بها)، لكنّ هؤلاء الآباء يُصابون بالارتباك حين يزورون السودان مع أطفالهم، فالطفل يُصدمُ بسؤالٍ جوهري: إذا كان هذا الشعب عظيماً بهذا القدر، فلماذا يعيش في هذا البؤس المُزرِي؟
لكنّ البرجوازية، بسطحيّتها المعهودة، عاجزةٌ عن فهم سياق التاريخ واقتصاده السياسي المُعولَم، ذلك النظام العالمي الذي يقسو على أطهر الشعوب بينما يُمجّدُ أفظعَها نهباً وعنفاً. وفي غياب القدرة على تحليل هذه التعقيدات، يلجأون إلى الحلّ السهل: اختزال كلّ هذا الدمار في “الكيزان”، وكأنّ السودان كان جنّةً مفقودةً قبل 1989! وهكذا يُورِثون الجيلَ الثاني نفسَ عُصابهم، وأحكامَهم اليائسة، وفانوسَهم الكمبرادوريَّ الذي لا يُضيء إلا ظلامَهم. ومن هذا نشأ جيل ثاني سوداني يعاني من نفس عصاب الوالدين وأحكامهما اليرقانية وحمل فانوس الظلام الكمبرادورى منهما.
في الطرف المقابل، برزت تيارات استحكمت فيها كراهيةٌ عميقةٌ واحتقارٌ مطلقٌ لكل ما هو سوداني، في مقابل تمجيدٍ أعمى للذات. وهذه الجماعات تُجسِّدُ أقصى درجات الضلال الفكري والسطحية المُنهَكة.
كانت الصفقةُ حلواً بامتياز، لأنها لم تُعفِ النخبةَ من مسؤولية التفكير العميق في أزمات السودان المعقدة فحسب، بل منحتها براءةً مطلقةً من أي دور فيها. بينما الحقيقة هي أن الأزمات التي خنقت السودان خلق جزء منها واستدامها نظام البشير، ولكن جزء منها تراكماتٌ تاريخيةٌ من إخفاقات الماضي، أو مؤامراتُ معارضةٍ غبيةٍ وعميلة، أو نتيجةٌ حتميةٌ لنظامٍ عالميٍ إمبرياليٍ قمعيٍ صمَّمَ شروطًا تنمويةً مجحفةً للدول الفقيرة.
لكن زيفَ هذه الرواية عن نبل وشطارة الجميع عدا الكيزان انكشفَ فجأةً بعد سقوط البشير، حين فشلت هذه النخبةُ فشلاً ذريعاً في إدارة المرحلة الانتقالية، مما قاد البلاد إلى الانهيار السياسي والاقتصادي ثم إلى الحرب. قد يختلف البعض حول نوايا هذه الصفوة، لكن لا خلافَ على ضحالة أدائها وعجزها الفكري والسياسي.
وما ضاعف إغراءً في هذه “الصفقة” هو أنها واءَمَتْ بين كراهية النخبة للإخوان والخطاب الغربي المعادي للإسلاميين بعد سقوط الشيوعية مطلع التسعينيات. فالإمبراطوريات تحتاجُ دائماً إلى “شيطان” لتبرير عدوانها، وقد وجد الغربُ في الإسلاميين البديلَ الأمثل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وهكذا، أصبح اتهامُهم بكل شرٍّ وسيلةً سهلةً تستخدم لكسب ودِّ الغرب القوي، خاصةً في أوساط الليبراليين واليساريين الذين أرادوا الحفاظ على “ثوريتهم” دون التورط في مواجهةٍ مع الإمبراطورية!
في أواخر الثمانينيات، سُئل محمد إبراهيم نقد: هل الحزب الشيوعي السوداني هو الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط؟ فأجاب: “هذه دعاية نظام مايو لاستجداء الدعم الغربي بمزاعم محاربة الشيوعية”. وأضاف: “حزبا العراق وجنوب أفريقيا أكبر منا”. لطالما أدرك الشيوعيون عالميًا أن الإمبراطورية تُضخِّم خطرهم لتبرير عدوانها. حتى اليوم، تتهم إدارة ترمب المحتجين على سياساتها بـمساندة الماركسية والإرهاب الإسلامي – في تناغم تام مع كتاب الحلف الجنجويدي ألذين يصفون أي مخالف لخطهم بانه إسلامي أو ماركسي مغفل في خدمة الإسلاميين .
لكن بعض اليساريين السودانيين “نسوا”دروس التاريخ حين أصبح الإسلاميون هم العدو المُعلَن، فانخرطوا في لعبةِ إلقاء اللوم عليهم كـ”سببٍ وحيد” لأزمات السودان والتعامي عن أخطار خارجية وداخلية فادحة، لأنها لعبةٌ مريحةٌ تبرئ الجميع من مشقة منازلة الإمبراطورية ووكلائها في أوساط البرجوازية السودانية.
لا شيء في هذا المقال يعفي الإسلاميين السودانيين وغير السودانيين من من جرائمهم أو أخطائهم ولا من أي إرهاب ارتكبوه. فقد عارضنا نظام البشير بلا توقف ولا هوادة منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩ إلي يوم ١١ أبريل ٢٠١٩ في حين هادنه مزايدون ودخلوا في برلمانه ونالوا المرتبات والامتيازات بعد صفقة نيفاشا واتفق معه أخرون علي الدخول في جلبابه كشريك صغير تحت غطاء إنتخابات ٢٠٢٠. هؤلاء يمتنعون.
معتصم أقرع







