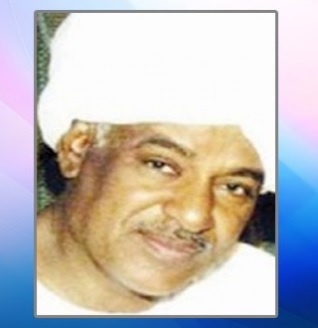كيف يعيد اقتصاد التكافل الأمن إلى الأمم؟
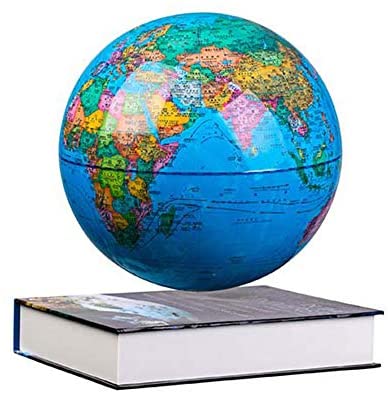
العالم اليوم لا ينهار، لكنه يتباطأ.
تُظهر أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أن معدل النمو العالمي سيبلغ نحو 3.2%، فيما تقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) معدلات النمو ما بين 3.0 و3.2%، بينما يتوقع البنك الدولي حوالي 2.3%. لسنا إذن في ركودٍ عالمي شامل، بل في توسّع هشّ وغير متوازن. التضخّم انخفض عن ذروته في عام 2022، لكنه ما يزال متقلباً وعنيداً في بعض المناطق. إنها حالة من المرونة المتوترة وتوازن دقيق على حافةٍ اقتصادية ضيقة.
في مثل هذا السياق، يبرز مفهوم “فنّ الدولة المتقشّفة”: أي فنّ الإنفاق الأقلّ على المظاهر، والأكثر على ما يبقى ويثمر. ليس تقشّفاً بالمعنى العقابي، بل انضباطٌ ذكيّ وتنسيق بين الحكومات والأفراد لإعادة توجيه الموارد من التبذير إلى العدالة، ومن البهرجة إلى الكفاءة.
هنا تستطيع الحكومات أن تبدأ من التفاصيل اليومية التي تُهدر الموازنات: السفر الرسمي المتكرر، المؤتمرات الفخمة، والاجتماعات العابرة للقارات‘ إذ تؤكد منشورة في مجلات Nature وWiley Sustainability أنّ المؤتمرات الافتراضية أو الهجينة تقلّص التكاليف والانبعاثات بنسبة تتراوح بين 60% و90% دون أن تضعف التعاون العلمي أو المهني. الأمر لا يقتصر فقط على وقف الهدر في الموازنات وحسب بل أيضاً إعادة توجيه الإنفاق العام في الملفات ذات العلاقة المباشرة مع النمو الاقتصادي ، فمثلا إن إعادة توجيه نصف هذه الوفورات على الأقل نحو صناديق البطالة، ومشروعات مكافحة الفقر، وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية كفيلة بإحداث تحوّل مالي واجتماعي ملموس. مراجعة نفقات السفر خلال ستة أشهر، واعتماد مبدأ “الافتراضي أولاً” يمكن أن تكون خطوة صغيرة تُحدث فرقاً كبيراً.
الاقتصاد المتقشّف ليس اختراعاً جديداً. لقد مارسه أجدادنا في أحياء عمّان والقاهرة ونابولي، لا باعتباره حرماناً، بل تضامناً، ولا بوصفه جزء من الانغلاق بقدر ما هو وعي متقدم بأساليب الحماية الاجتماعية وإدارة الاقتصاد والموارد، كانت الأفران تُتقاسم، وأدوات الحصاد تُتبادل، وجمعيات الادّخار الصغيرة (الجمَعيات) تُقام على الثقة والمحبة. كانت تلك الشبكات الشعبية دروعاً اجتماعية صلبة، يشارك فيها الجميع لتحصين الحياة اليومية. كان عطاء الجماعة بديلاً عن القروض، وكانت الثقة رأس مالٍ مشترك. ومع صعود ثقافة الاستهلاك، خَفَت هذا النَسق الجماعي وتراجع نمط من اقتصاد تكافلي كان سائداً، وانعكست العدوى على الدول التي راحت تُنفق أكثر على المظهر وأقل على الجوهر. غير أن اقتصاد التضامن يذكّرنا بأنّ الأمن يبدأ من البساطة، والاستدامة من الترشيد.
تخيّلوا لو أنّ الدول عاملت الانضباط المالي كقيمة مدنية لا كإجراء تقشفي؛ ولو أن الموازنات التي تعرّف بأنها أداة للتخطيط كُتبت لا لتُبهِر، بل لتحمي. فالتضامن في أوقات الاضطراب ليس حنيناً للماضي، بل استراتيجية بقاء، والحَوكمة الرشيدة لا تعني فقط ضبط النفقات، بل ترميم الثقة بين الدولة ومواطنيها، وبين الجيران في ما بينهم.
أما الأُسر، فعليها أن تُعيد اكتشاف ميزانها: قاعدة 50-30-20 (50% للحاجات، 30% للرغبات، 20% للادخار وسداد الديون) تصلح قاعدة للحياة اليومية حين تُكيَّف مع الأسعار المحلية. “ادفع لنفسك أولاً”، قلّل الدَّين، واستثمر في الصحة والتعليم والكفاءة. يمكن للحكومات أن تدعم ذلك عبر حملات للتربية المالية في الجامعات والبرامج الاجتماعية، وعبر استخدام سياسات التحفيز الذكي لتسهيل الادخار والاستقرار المالي للأسر.
في التاريخ، لم تكن الأمم الأكثر ثراءً هي الأطول بقاءً، بل تلك التي أتقنت فنّ التدبير، وفي زمن التباطؤ العالمي، علينا أن نستعيد حكمة العيش البسيط والإدارة الرشيدة.
إنّ فنّ الدولة المتقشّفة، حين يُقرَن بروح التضامن، قادرٌ على تحويل الضيق إلى قوة، والعجز إلى إبداع، والحقيقة التي تتبدى في أكثر صورها جلاءً أن المستقبل لن يكون لمن يُنفِق أكثر، بل لمن يُنفِق بحكمةٍ وبروحٍ مشتركة.
أ. د وفاء عوني الخضراء – وكالة عمون الإخبارية