رأي ومقالات
د. عبدالوهاب الإفندي : الغياب الكامل للمعارضة، يدل فقط على أن المعارضة أكثر بؤساً وإفلاساً. ولا نبرئ أنفسنا فنحن من المعارضين للنظام، وممن يتمنى زواله بأسرع ما يمكن

من المفترض أن يصب مثل هذا الفشل البين في مصلحة المعارضة، ويؤدي إلى التفاف الجماهير حولها، وهو ما لم يحدث. فالمعارضة في حالة تشرذم وتخبط لم تغير منه كثيراً ضوضاء اتفاق ما سمي بـ «نداء السودان»، الذي جرى توقيعه في أديس أبابا الأسبوع الماضي. أولاً، لأن هذا البيان كان تكراراً مملا لبيانات وتوافقات سابقة، كان أولها إعلان التجمع الوطني الديمقراطي عام 1990، ثم إعلان أسمرا عام 1995، ثم وثيقة «الفجر الجديد» مطلع العام الماضي، وأخيراً «إعلان باريس» في آب/أغسطس الماضي. ولا يكاد المتابع يجد كثير اختلاف بين هذه النصوص، التي تتراوح بين العموميات التي لا يختلف عليها أحد، وبين تمني الأماني وبيع الأوهام، مثل الحديث عن «انتفاضة محمية بالسلاح»، أو الجمع بين طلب التفاوض مع النظام والحديث عن تفكيكه في نفس الجملة. وليس أدعى إلى الشفقة من أن احتفال المحتفلين بتوقيع مثل هذه التوافقات إنما ينبع من أنها جمعت بين حركات سياسية مدنية من جهة، وحركات تحمل السلاح من جهة أخرى. ولا نحتاج لنكرر هنا ما أوردناه سابقاً من أن هذا دليل ضعف لا قوة، فوق أنه دليل غياب للفهم السياسي الصحيح يكشف عنه خطل اعتقاد القوى المدنية بأن ضم الحركات المسلحة إلى صفوفها يقويها. ولكن العمل العسكري، حتى حين كانت تقوده حركة قوية موحدة ومدعومة من كل العالم تقريباً، كما كان شأن الحركة الشعبية بقيادة العقيد جون قرنق، لم ينجح رغم استمراره لعشرين عاماً من استنقاذ مدينة واحدة من مدن الجنوب الرئيسية من قبضة الحكومة. أما حركات دارفور التي ظلت تحارب لعقد من الزمان، فلا تسيطر على قرية واحدة ذات شأن، ناهيك عن مدن الإقليم. وحتى قبل أن تفقد جل الدعم الخارجي في السنوات الأخيرة، ظلت هذه الحركات تصرف معظم الوقت والجهد في التقاتل فيما بينها، وعجزت حتى هذه اللحظة عن توحيد صفوفها. وخلال هذه الحروب، عانى سكان هذه الأقاليم المنكوبة من الخسائر في الأرواح والأرزاق ما جعلهم يحنون إلى الأوضاع التي ثار ضدها الثائرون.
كثير من هذه الحركات متهمة بارتكاب تجاوزات لا حصر لها، ولو تم تنفيذ نصوص «نداء السودان» المتعلقة بالعدالة والمساءلة لما نجا قيادي من قياداتها. فإذا كانت هذه سفينة النجاة التي تعتقد المعارضة أنها تمتطيها إلى السلطة، فإنها بالفعل سفينة مليئة بالثقوب، وهي آية يأس تشبه حال الشباب الذين يركبون قوارب الموت هرباً من البؤس إلى هلاك مرجح.
نحن هنا إذن أمام حالة بؤس سياسي مقيم، تعتاش فيه المعارضة على فشل النظام وتهافته، ويبقى النظام لأن المواطن يتأمل المعارضة فيرى من بؤسها ما يمنعه من التطلع إلى أيام حكمها لو جاءت- بأي قدر من التفاؤل. فإذا كانت المعارضة تحتاج إلى عقدين أو أكثر لصياغة بيان مشترك، وتحتاج إلى السفر إلى الخارج لتوقيعه، فكيف تقنعنا بأنها قادرة على إدارة بلد مثل السودان؟ وإذا كانت المعارضة لا تفهم الفرق بين الانتفاضة الشعبية المدنية والحرب الأهلية، فكيف نطمئن إلى أنها تفهم في أبجديات السياسة؟ فلو صدقت أماني هؤلاء وتحولت الخرطوم إلى مقديشو أخرى، فأين سيذهبون؟
وإذا كان للأحزاب السياسية الكبرى والصغرى كوادرها ودورها ومؤسساتها وصحفها داخل البلاد، فلماذا تحتاج إلى السفر إلى كمبالا أو أديس أبابا لتوقيع بيان؟ ولا حجة هنا بالتذرع بقمع النظام، فقد قامت الثورات في سوريا وليبيا، وكلاهما يحكم بالإعدام على من ينتمي لبعض الأحزاب، ولا يسمح بمعشار الحريات المتاحة في السودان للأحزاب والمنظمات المدنية. فالمعارضة الشعبية الحقيقية لا تحتاج إذناً من النظام لتسعى إلى إسقاطه. ولم يكن في دول أوروبا الشرقية حين قامت ثوراتها أحزاب سوى الحزب الشيوعي، وكان في معظمها رجال أمن ومخبرون يزيدون عشرات الأضعاف على الناشطين الممنوعين بدورهم من مجرد الاجتماع والتلاقي.
استمرار نظام مثل الحكم القائم الممعن في فشله وبؤسه، وفيما يشبه الغياب الكامل للمعارضة، يدل فقط على أن المعارضة أكثر بؤساً وإفلاساً. ولا نبرئ أنفسنا، فنحن من المعارضين للنظام، وممن يتمنى زواله بأسرع ما يمكن، شريطة ألا يكون ذلك بطريقة نتحسر فيها بعده على زواله. ولكنا لسنا سياسيين محترفين، ولم نكن، ولا نريد أن نكون. فاحتراف السياسة في السودان، خاصة في ظل غياب المبدئية السائد، هو اشبه بالداء العضال، والخوض في الوحل.
وقد يكون في الخوض الوحل محموداً ومطلوباً أحياناً لإنقاذ ضحايا الفيضانات ونحوها، وهو كذلك في الطوارئ السياسية والشدائد. ولكن بؤس السياسة السودانية وما تشهده من تهافت الخطاب السياسي وبؤسه، وغلبة القبح وفحش القول على لغة التحاور، تجعل حتى من جعل السياسة مهنة وحرفة يزهد فيها، ويتمنى أن يتبع سنة مصطفى سعيد، بطل رواية الطيب صالح «موسم الهجرة إلى الشمال»، فينفي نفسه إلى قرية نائية لا يعرفه فيها أحد، ويهجر الفكر والكتابة والسياسة إلى حرفة الزراعة ونحوها، فيريح ويستريح.
وهذا يجعلنا ندور في حلقة مفرغة تواجهنا بسؤال ملح حول كيفية الخروج منها. فالسياسة السودانية في شأنها الحالي ليست مما يستهوي أهل القدرة والكفاءة لما يكتنفها من فساد وإفساد وتردٍ في الممارسة والخطاب، وتراجع للمثل والخلق. ولكن حالها لن يصلح ما يقبل عليها أهل الكفاءة والقدرة والنزاهة وكرائم الأخلاق. فكيف يكون المخرج؟
في رأينا أن هناك حاجة لدور فاعل لمنظمات المجتمع المدني والمثقفين، يشبه الدور الذي لعبه الاتحاد العام للشغل في تونس، أو شخصيات دينية-فكرية مثل الأسقف ديزموند توتو في جنوب افريقيا. وينبغي أن ترتفع هذه الفئات فوق الانقسامات «الطائفية» (بالمعنى الأوسع للطائفية من سياسية وعرقية وأيديولوجية)، وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وتعزل نفسها من الفعل السياسي المباشر على سنة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، حين أخرج نفسه من المنافسة على السلطة فرضي به الآخرون حكماً بينهم. فهناك حاجة إلى مبادرة من ائتلاف من منظمات مدنية ذات صدقية وحياد، ورموز فكرية وثقافية ذات صدقية ومكانة، تطرح رؤية جامعة لمستقبل تعايش ديمقراطي بين جميع فئات المجتمع السوداني على أسس من قيم الحق والعدل وحفظ الكرامة الإنسانية للجميع، وعلى هدى هوية وطنية جامعة يجد الكل أنفسهم في كنفها.
فإذا كانت السياسة السودانية مريضة، فإن علاجها يجب أن يأتي من خارج السياسة، ومن جهات اكتسبت المناعة من عللها.
د/ عبد الوهاب الأفندي
صحيفة القدس العربي
خ.ي[/SIZE][/JUSTIFY]





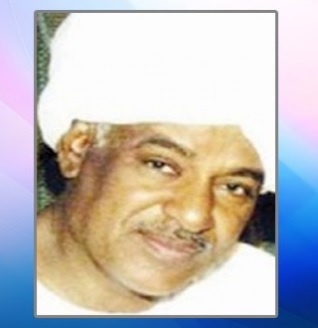

الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين.
الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين.
منافق أفندي .. لقد أتى دوركم في التخذيل بعد أن اجمعت المعارضه رايها ووحدت أمرها .. أنت أيضا يامنافق في القوايم السود . سوف يطالك العقاب العادل يوماً ما
التركيز علي بنا مجتمع يسوده القانون والبعدعن سيطرة فئة بعينها علي امكانيات البلد الاقتصاديه والساسيه اولئ في الوقت الحالي من تغير لنظام