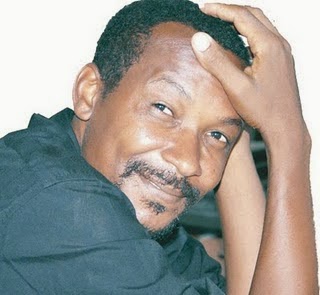رسائل إلى زينب 1

في الطريق المؤدي إلى “البحر” عند مرسى الموردة، وأنا أتفادى كتل الطمي المتشققة تعثرت بصندوق حديدي صدئ، حملته معي وعدت إلى البيت، وفي ليل يومي ذاك كسرت أقفاله وفتحته. وجدت أوراقا مرتبة بعناية داخل كيس نايلون، أخرجته برفق، كانت مجموعة رسائل، كتبها عاشق ما إلى حبيبة اسمها “زينب”. كان التاريخ، ولحيرتي يتحقق بعد عشرات السنوات من الآن؛ لكنني بسطت الأوراق وقرأت أولى الرسائل:
“يا زبيب، وأنا مقصى الآن عن نزقي وحنيني، غائب في “مأزقيتي” وحيرتي؛ محاصر بأسئلة الشوق ونزف النداء، أسفل جدار حصاري الزجاج، ارتد إلى نفسي وأناجيها: متى أحببتك يا زينب، أي الأزمنة شبكتني بك وأرجحت روحي بين مداك ومداك. لا تذكرين ما لم تريه. داخل قاعة المؤتمرات بجامعة الخرطوم، ما نسيته أنا، تذكرينه أنت، اسم المحاضرة، وناسها والصخب المشحون في المكان الضيق. ما أذكره – قلت – لن تتذكريه إلا بسماعي الآن. كنت تشقين الصفوف المتراصة وتبعدين من أمامك الأكتاف المتلاصقة. وكنت أنا أقف عند أعلى مكان في القاعة، أبصرتك من هناك، لمحت ذلك الحزن الممتزج بالغضب وهو ينعكس من عينيك وأنت تبعدين المتزاحمين عن جسدك، كنت تنوين الخروج قبل بدء الندوة، وكنت في شهرك التاسع من الحمل، وكنت أنا مشدودا بذهول إلى عينيك الحزينتين وجسدك المتمايل في غضب. أخفتك الجموع؛ ولم أرك بعدها إلا بعد سنوات طويلة، لكن؛ يا زينب، عيناك، نظرتهما، شيء ما فيهما ظل راسخا متكونا وثابتا لم يبارحني قط. هل عشقتك وقتها؟ هل أحببتك هكذا: امرأة مستنيرة، حامل في شهرها التاسع تخرج غاضبة من فعالية ثقافية ما وبعينيها حزن وسحر آسران كبلاني إلى أبد!”.
تلك كانت الرسالة الأولى قرأتها بتمهل في أواخر ليل يومي ذلك. كان الخط الذي دونت به جميلا، والورقة خشبية اللون نظيفة لم تتأثر بالحبس النايلوني أو بطوال السنوات التي افترضتها للصندوق الحديدي وهو مخفي في قاع النهر – البحر، أو بين طين طمي مرسى الموردة. أحسست بالفضول لمعرفة فحوى بقية الرسائل المرتبة على الفراش. لكنني أجلت ذلك إلى ليل آخر، فغدا أمامي يوم عمل طويل والفجر بات يقترب وعما قليل ستضج شوارع المدينة بالغادين والرائحين بحثا عن أرزاق باتت تتأبى وتستحيل.