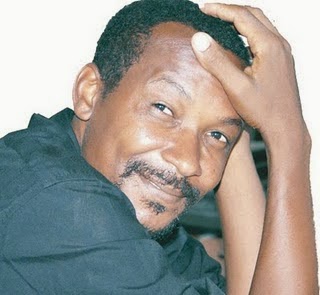فيلم عرس الزين

نتيح المساحة اليوم للكاتب الشاب مأمون الجاك:
قبل عدة أيام شاهدت فيلم (عرس الزين) المأخوذ من رواية للطيب صالح بذات العنوان، مجهود مقدر قام به طاقم العمل بالنظر للإمكانيات المتاحة خلال الفترة التي صدر فيها الفيلم -1976.. متغلبين على عديد المصاعب التي واجهتهم, منها مادة العمل ذاتها, فروايات الطيب صالح لا تسير في خط مستقيم من البداية للنهاية, ولكن تختلف طريقة سرده وتنقلاته بين الأحداث من عمل إلى آخر. لكن يؤخذ عليهم تخليهم عن صوت الراوي السارد مما جعل الفيلم يبدو ساذجاً ومفككاً, ولمن لم يقرأ الرواية فإن الفيلم ربما سيصيبه بالإحباط.
عندما تشاهد فيلماً روائياً, فأنت أمام عمل مرّ بمراحل ولادة متعددة: من رحم الكون إلى مخيلة الكاتب, للسيناريست, ثم رؤية المخرج, وأخيراً تقمص الممثل وأداؤه.. ذلك المخاض الطويل سينقص أشياء كثيرة: الانفعالات, تداعي الذكريات والأفكار.. وقد يقتل الإحساس الذي يراودك بأن (الزين, زوربا, وخوسيه أركاديو بوينديا –الأب-) يمتلكون ذات الشخصية المبادرة الهوجاء, ولهم نفس الطبائع والصفات وإن اختلفت الملامح والسحنات, وأيضاً ستنقص دهشة الاكتشاف ولذة المعرفة, فذلك متعلق فقط بالقراءة. لكنها ستضيف أشياء أخرى بالمقابل … أما عندما تقرأ النص –رواية/قصة- فإلى جانب كونك قارئاً فأنت تصبح كاتباً وبطلاً كما قال بورخس: أيا من كان يقرأ كلماتي هو يختلقها بنفسه، الكتب في المكتبة لا تملك حروفا.. بل تنبثق عندما أفتحهن وفي الوقت الذي يطالب فيه السينمائيون الجمهورَ بأن ينظر للفيلم المستمد من رواية كعمل مستقل يُقدم من وجهة نظر بعيدة كل البعد عن العمل الأصلي, مركزاً بالتحديد على جزئية بعينها, فإنهم أنفسهم يتناسون ذلك؛ فالمخرج يحاول إبراز رؤيته لا نقل الرواية كما هي –وهو شيء مستحيل طبعاً- فها هو المخرج الكويتي (خالد الصديق) يقول بأنه ركز في -عرس الزين – على عرض فكرتين: النفاق الديني المتمثل في شخصية الإمام، ونقل الفلكلور السوداني، مما جعل كثير من التفاصيل المهمة تتساقط وسط هذا القصر. في الحقيقة قد يكون الأمر أكثر تشعباً من ذلك, فهنالك روايات عادية تحولت إلى أفلام جيدة, وبالمقابل روايات عظيمة فشلت كأفلام. ماركيز مثلاً رفض عروضاً كثيرة لتحويل رواياته إلى سيناريوهات مرئية، لأن الصورة تؤطر الشخصية، وذلك مع أن روايته (الحب في زمن الكوليرا) حُولت إلى فليم رائع كذلك هو الحال لأغلب الروايات العربية التي أنتجت كأفلام: أعمال – إحسان عبد القدوس, نجيب محفوظ, يوسف السباعي, علاء الأسواني وغيرهم، إذ تفاوتت درجات جودتها ونجاحها.. فإذا أخذنا مثلاً فيلم (السقا مات) لـ (يوسف السباعي) فإننا نجد أن أداء (عزت العلايلي) كان خارقاً, فقد نجح ببساطة في نقل المفارقة والتناقض وفلسفة الموت المصاحبة للرواية كما إستطاع تجسيد شخصية السقا بكل بؤسها ونظرتها التشاؤمية للحياة على العكس من ذلك أخفق الكثير من الممثلين في تجسيد شخصيات روائية وصاحب ذلك فشل المخرجين أيضاً وتركيزهم على الأحداث السطحية، والتصرفات الظاهرية للشخصيات وإغفالهم للمعنى الخفي المتواري ورائها مما جعل تلك الأفلام أشبه بالنشرات الاخبارية، ورغم أن تقدم صناعة السينما ظل دائماً تقنياً وآلياً.. إلا أن الهواجس, التوتر والإنفعالات بقيت كما هي.
إنك عندما تضع كاتباً ما, أمام مشهدٍ طبيعي طالباً منه أن يصفه, فإن أول ما سيفعله بعد النظرة الأولى هو إغماض عينيه لتثبيت اللحظة والصورة محاولاً استرجاعها بعد ذلك, وهذا بالتحديد هو عكس ما سيفعله الرسام والفتوغرافي – إذا استثنينا أمر التشكيليين والسرياليين- ألا يدل ذلك على أن الصورة والشعور قبل الكلمة؟ ولكن أليس من البداهة أن تصلح الرواية الجيدة كفيلم لدقة وصفها, تماسكها وتجسد شخصياتها؟ أليس العمل الروائي مأخوذ في الأصل من صورة الواقع؟!
إن علاقة التطابق بين النص والصورة، الفكرة والشعور، علاقة صعبة التحقق لذلك كانت العلاقة التكاملية بين الرواية والسينما، كل منهما استفاد من الآخر، الأفلام مبنية على نصوص مكتوبة والروايات الحديثة أخذت من الأفلام نسقها وقدرتها على شد انتباه الرائي من البداية إلى النهاية, الانتقالات بين المشاهد، التحولات والمنعطفات. تتسع هذه العلاقة التكاملية لتشمل كل أشكال الفن، لتصبح تلك المقارنات الدائمة والحديث عن كون هذا الزمن أو ذاك هو زمن الرواية أو زمن الشعر مجرد جدالات عبثية بلا طائل.