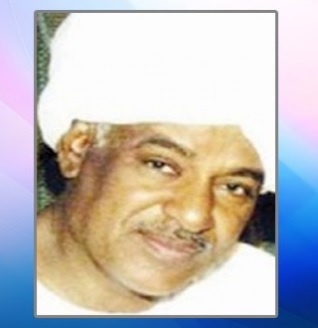على مشارف مائة عام من ثورة ١٩٢٤م

١٩٢٤ السودانوية ترياق العنصرية
القبول المشترك وحق الآخرين في أن يكونوا آخرين، مفتاح بوابة المستقبل السوداني:
لوحتان من عبق التاريخ:
عند تحرير الخرطوم فى يناير ١٨٨٥ كان قائد الثورة وجيش التحرير دنقلاوى من جزيرة لبب وكان يتحدث بلغة الدناقلة بطلاقة كما ورد في المراجع التاريخية ومن الذين عاصروه، وهي لغة سودانية اصيلة ومن لغات العالم القديم وليست (رطانة)، وامعاناً في رغبة البعض في التفوق فقد نسبوه للأشراف وللحسن بن علي وفاطمة الزهراء، مع إن إنتسابه الي ترهاقا اكثر واقعية ولا يقلل من قيمته العظيمة في تاريخ السودان، وقد كان نائبه (ود تورشين الخليفة عبدالله التعايشي) من أقصى غرب السودان والقادة الآخرون؛ عثمان دقنة من البجا فى الشرق والعبيد ود بدر من الجزيرة و عبدالرحمن النجومى جعلي من نهر النيل و ابو قرجة دنقلاوي من الولاية الشمالية وحمدان ابو عنجة من الكارا والزاكى طمل …الى آخر القائمة، وهي لوحة من لوحات البناء الوطني.
كانوا يمثلون لوحة سودانية في تضادٍ مع ما يجرى الآن، وكم كانوا عظاماً. وفى ثورة 1924 رسم على عبد اللطيف وعبيد حاج الامين وصالح عبد القادر وعبدالفضيل الماظ وسليمان محمد وفضل المولى وثابت عبدالرحيم وسيد فرح … وبقية عقدهم الفريد، رسموا لوحةً أخرى هي في الواقع امتداد للوحة الأولى، والواقفون في اللوحتين يمثلون شعب السودان كله، أما لوحة اليوم تسدد طعنةً نجلاء للوحتي الماضي، ولذا توّجب أن تستعيد لوحاتنا المسروقة من عبق التاريخ.
نحن على مشارف مائة عام من ثورة ١٩٢٤ آن لنا أن نزيل غبار السنين والشوائب المتعمدة التي علقت بهذه الثورة، وهي تجسد لحظة مفصلية من لحظات انبثاق الوعي الوطني والبناء الوطني كما تحتاجها بلادنا اليوم. لابد من تقويم سديد لهذه الثورة ووضعها في الإطار التاريخي اللائق بها في مسيرة تاريخنا التي تمتد لأكثر من سبعة الف عام، ولنحتفي جميعا بروح ثورة ١٩٢٤ ومعايير القيادة الجديدة التي وضعتها وبكفاحيتها ضد العنصرية وإرث تجارة الرقيق، وقضية القبول بالآخر، وأن يُقبل السودانيون بعضهم على بعض، وهي القضية التي شكلت إحدى مأسي بلادنا وأعاقت تطورها.
السودان اليوم في مفترق الطرق فقد غادر جنوب السودان، ويستعد آخرون لحزم أمتعتهم، ولا بدّ لنا من العودة إلى طمي الأرض وبذورنا التي اختزناها لأوقات الشدة وأزمنة العواصف، وثورة ١٩٢٤ بذرة صالحة لنغرسها في طمي الأرض وإن تأخرنا مائة عام فالخير خير وإن طال الزمان به، ونحن ندعو للاحتفاء على مدى الست سنوات القادمة بالذكرى المئوية لثورة ١٩٢٤ في مؤسساتنا الشعبية والرسمية، وان نعبر عنها بكافة وسائل الإبداع وأن يأخذ شبابنا مقعدهم في مقدمة هذا الاحتفاء، فثورة ١٩٢٤ هي ثورة الشباب.
ثورة ١٩٢٤ هي من أولى الحركات السياسية الحديثة خارج الطوائف والتفكير والبناء التقليدي لمجتمعنا، وهي أم التنظيمات السياسية الحديثة ومرجعيتها وحملت في طياتها أسئلة البناء الوطني والهوية، وكانت طيفاً وخيالاً ورؤى وأماني جزلة، وعلينا أن نتحلق حولها كالفراشات على نار الهوى، وبالعودة إليها نعود الي روحنا وإرثنا الوطني، فهي ما تزال شابة وفتية وبداخلها رابط قوي بين الشمال والجنوب، فبعض أهم قادتها ينحدرون من الشمال والجنوب على حدٍ سواء، وهي جزء من الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية.
الحديث عن أن السودان الحالي هو مجرد رابطة جغرافية، حديث ينقصه التاريخ وتنقصه الثقافة، فالسودان الحالي ظل على الدوام منطقة جغرافية ذات روابط اجتماعية وثقافية وسياسية وتاريخية مشتركة أوسع من بلاد السودان الحالية، والذين يقولون بغير ذلك يحاولون التمترس حول عقيدة لا ترى الماضي وتريد إلغاء الحاضر دون بديل للمستقبل، وقد ثبت من تجربة انفصال الجنوب الأخيرة ان رؤية السودان الجديد هي وحدها التي تقدم البديل، وإن قضية الوحدة هي عظم الظهر في هذه الرؤية، وهي الجديد التي أتت به هذه الرؤية سودانياً وإفريقياً، فتقسيم المجتمعات الافريقية على أسس اثنية أو دينية يخدم مصالح القوى التي تسعى لنهب البلدان الافريقية، وان الانقسامات الاثنية والدينية لا حدود لها، فهي لن تكتفي بتقسيم البلدان الافريقية الحالية بل ستقسم حتى المجموعات الاجتماعية والقبيلة الواحدة التي تظن نفسها متجانسة وبمنأى عن التقسيم، ولذا فإن طرح قضية وحدة افريقيا وبلدانها في مواجهة التخلف وقوى النهب العالمي هي قضية ذات أهمية قصوى للثورات الوطنية الديمقراطية في البلدان الافريقية. والذين يطرحون حق تقرير المصير على أساس إثني فإنهم يرقصون في وليمة من الولائم التي تقيمها قوى النهب العالمي.
مكافحة العنصرية في أكثر المجتمعات تقدماً عملية طويلة من الاقتصادي والثقافي والسياسي والقانوني والتاريخي، وهي ظاهرة كونية غير متعلقة باللون فحسب بل أشمل وأعمق حتى من قضايا اختلاف اللون، فقد وحّد القائد الايطالي غاريبلدي شمال وجنوب إيطاليا وهما يحملان اختلاف سمات المجتمع الزراعي والصناعي، ولا تزال جروح التعالي تضرب إيطاليا وكثير من المجتمعات ذات اللون الواحد، وبعد حركة الحقوق المدنية الواسعة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قضية البناء الوطني المنسجم بعيدة المنال في الولايات المتحدة.
وفي استدعاء ثورة ١٩٢٤ فاننا نستدعى عملية شاملة من النهوض الوطني والسياسي والمجتمعي يحتاجها شعبنا اليوم، وعلى الجيل الجديد أن يرد الاعتبار لثورة ١٩٢٤ كاعلى محاولات السودانيين في تجربتهم السياسية قبل استقلال السودان في يناير ١٩٥٦ لتجاوز العنصرية؛ واستحداث نسق مغاير لا سيّما على مستوى القيادة والمشاعر والتلاحم الإنساني الذي ابداه قادة ثورة ١٩٢٤ وهم ينحدرون من مجمل التنوع السوداني فكم كان ذلك ساحرا وفريدا ومؤثرا، وهو انجاز لوحدة مجتمعنا بالاستناد على تنوعه.
لقد كانت حركة اللواء الأبيض اكبر التنظيمات الحديثة ذات الرسم والصورة المكتملة والشعار ولها رؤية سياسية واضحة، عمد خصومها على تجاهلها، والصور الفوتوغرافية الجميلة باللون الأسود والأبيض التي تركها قادة الحركة تمثل جنين وحدتنا وتنوعنا، إن ثورة ١٩٢٤ بذرة من بذور الوطنية الحديثة، وهي حركة جماهيرية منحازة لمصالح الشعب السوداني.
لعل الباحث والمدقق في تاريخ انحياز القوات المسلحة في عام ١٩٦٤ وعام ١٩٨٥ في انتفاضتي أكتوبر وابريل يُرجع جذور هذا الانحياز الي الموقف الوطني في داخل قوة دفاع السودان الذي ابتدره علي عبداللطيف وعبد الفضيل الماظ وثابت عبدالرحيم وحسن فضل المولى وسليمان محمد وعلي البنّا وغيرهم، انها بذرة رووها من دمهم وشربت من تضحياتهم وقامت على اكتافهم القوية.
حينما اختار ثوار ١٩٢٤ علي عبداللطيف قائداً لهم كانت حاجة العازة محمد عبدالله تلك المرأة بهية الطلعة والتي كانت تقوم بتأمين الاجتماعات وأول امرأة خرجت وهتفت في مظاهرة وحيت طلاب الكلية الحربية قد ذكرت أن الزعيم علي عبداللطيف قد سأل اكثر من مرة الحاضرين في ذلك الاجتماع عن اختيارهم له كزعيمهم وهي أسئلة تحمل محمولات وارث ما جرى في مجتمعنا من مساوي الماضي، ولكن اختيار علي عبداللطيف كان لحظة تاريخية فارقة في العبور نحو القبول المشترك وانما يوحد السودانيين ويجمعهم هو ان يتركوا خلفهم ما يفرقهم ويبحثوا في “المسكوت عنه” لبناء مجتمع على أسس جديدة، كما قال دكتور فرانسيس دينق ان “المسكوت عنه” هو الذي يفرقنا، وآن لنا في وسائل التواصل الاجتماعي ان نحتفي بحاجة العازة محمد عبدالله ونرسل مرة أخرى الفيديوهات التي تحوى المقابلات القليلة التي أجريت معها، وحاجة العازة محمد عبدالله ساهمت على نحوٍ ما في حركة النساء الحديثة في بلادنا، وهي مساهمة من افضال ثورة ١٩٢٤ وهذ المقالات مكرسة للإمساك بهذه اللحظة المفتاحية كواحدة من اعظم لحظات القبول الوطني المشترك والدفع ببناء وطني بآفاق جديدة. فواحدة من أكبر معضلات بلادنا هي قضية القبول بالآخر، لقد خرج جنوب السودان من بوابة رفض الآخرين وحقهم في أن يكونوا آخرين.
الجدير بالتأمل أن ضباط ثورة ١٩٢٤ تخلوا عن امتيازاتهم في وقت يصعب ان يحلم الكثيرون بتلك الامتيازات كضباط في قوة دفاع السودان، والاهم من ذلك انهم رفضوا سياسة (فرق تسد) التي استخدمها الانجليز، لاسيّما ان بعض هؤلاء الضباط كانت اسرهم من ضحايا تجارة الرقيق، وظن الانجليز بغشامة انهم سيكونون أسرى لماضي تجارة الرقيق، وسيوجهون بنادقهم اذا تطلب الامر الي صدور أبناء وطنهم، ولكنهم وجهوا بنادقهم الي صدور الانجليز وانحازوا الي الشعب، ولله درهم هؤلاء الفتية العظام، ويا لهم من وطنيين في أعلى مراقي سلم الوطنية – لقد جئنا وحررناك، أخرجوا انتم من بلادنا واتركونا عبيدا كما كنا- فقد اكتشف هؤلاء الوطنيين الكبار ان التناقض الرئيسي هو بين الاستعمار والشعوب التي استعمرها، وان التناقضات بين من تم استعمارهم هي تناقضات ثانوية، ولذا فان البنادق جميعها يجب ان تتوجه ضد المستعمرين، ومن الغريب بعد ما يقارب مائة عام يصعب على البعض في زماننا هذا إدراك هذه الحقيقة.
في نهاية القرن التاسع عشر، وفي مصر، ولعله في القاهرة نصب سرداق لحفل زواج فريد بين شابة من قبيلة المورو التي تقطن غرب الاستوائية والماظ عيسى الذي ينحدر من النوير في أعالي النيل، هذا الزواج المختلط لا زال يحمل كثير من المصاعب حتى في زماننا هذا، الماظ كان جنديا في الأورطة (١٢) التي شاركت في إعادة استعمار السودان رزق بإبن من هذه الزيجة المباركة، وحملت زوجته ابنها الذي لم يتجاوز الثلاثة أعوام وهم في طريقهم الي السودان مع جيش كتشنر، كان ذلك الإبن هو عبد الفضيل الماظ الذي استشهد لاحقا في معركة النهر الثانية، وقد رحلت والدته وخلفته وحيداً ونما عوده وطنياً بالكامل حتى خاض آخر معاركه في مساء الخميس ٢٧ نوفمبر ١٩٢٤م في المعركة التي انتقل بها الي مستشفى النهر (مستشفى العيون الحالي) والتي استمرت حتى ضحوة الجمعة ٢٨ نوفمبر ١٩٢٤م، ففي يوم الجمعة نفدت الذخيرة وأعطى الماظ الجنود أوامر بالانصراف والتجأ الي مبني المستشفى العسكري متحصناً واخذ الذخيرة التي يريد لمدفعه المكسيم والتي وجدها في المخزن التابع للمستشفى، واعتلى المبنى واتخذ من احدى غرفه حصناً منيعاً له، كانت ذخائر المكسيم هي الوحيدة التي استمرت في المعركة، لمدفع وحيد استلمه قائد القوة ملازم اول عبد الفضيل الماظ عيسى واستمر في حصد الجنود والضباط الانجليز وعجزوا عن الاقتراب منه، ففي يوم الجمعة كان الماظ وحيداً بشهادة سيد فرح الضابط الاخر الذي سنتطرق له لاحقا، فر سكان الخرطوم الي الغابة وبقى الماظ وجيش الانجليز في حوار ومواجهة متصلة بالذخيرة وحدها، وعند منتصف النهار في يوم الجمعة، ولعل الناس قد ذهبوا الي الصلاة أمرت طابية الخرطوم بإطلاق المدفعية الثقيلة وهدم المستشفى العسكري، وهي جريمة حرب، وعندما بحث الانجليز تحت الأنقاض وجدوا الماظ والمدفع، لقد شرب الماظ الوطنية من ثدي امه وهو عائد من نحلة الجرح القديم الي تفاصيل البلاد وكان وحده، واستشهد الماظ وهو ابن (٢٨) عاما، وليت كل من يولدون في ٢٨ نوفمبر من أي عام يطلق عليهم اباؤهم وأمهاتهم اسم عبد الفضيل الماظ، فالماظ جاء الي السودان وعمره نحو ثلاثة أعوام واستشهد بعد (٢٥) عاما من مجيئه المبارك، والماظ نطفة وانسان مكتمل جاء من امشاج الوطنية السودانية، سياتي من بعده الكثيرون على هذا الطريق وهنالك من يلد ضحايا، وإن لم نحتفي بالماظ فبماذا نحتفي يا هؤلاء؟
بعد أن شاهدت مسرحية أبيض واسود بدعوة من الصديق والمبدع محمد نعيم سعد، وهي من المسرحيات التي تستحق المشاهدة، وطلبت من أصدقاء كثر مشاهدتها لاسيّما من قادة الحركة الشعبية ووزرائها آنذاك من جنوب السودان، وشاهدتها مع زوجتي أوار دينق مجوك، ففي إعتقادي ان فكرتها البديعة تقوم على تناقص قيمة الانسان السوداني عبر الزمن حتى وصلنا الي الخمسين جنيه غير المبرئة للذمة، بعدها التقيت في منزل صديقنا طارق الأمين بصديقي الاخر محمد نعيم سعد، قلت له في تلك الأمسية لو كان لي أن أتمنى لتمنيت أن أترك هذا الضجيج السياسي جانبا وأساهم في كتابة سيناريو حول ثورة ١٩٢٤ وعبدالفضيل الماظ كشخصية رئيسية من شخصياتها، وقبل أيام من تركي للخرطوم في الحرب الثانية في يونيو ٢٠١١م طلبت من مجتبى عرمان أن ياتيني بكتاب ملامح من المجتمع السوداني للأستاذ حسن نجيلة، فإن الجوار بالقرب من عبد الفضيل الماظ ينعش فيض ذاكرتنا الوطنية المشتركة التي يحاول البعض أن يقنعنا بإن تاريخنا قد بدأ في ١٩٨٩ وآخرون يقفون في الضفة الأخرى ضد ١٩٨٩ ويشاركونها معزوفتها الموسيقية بإن لاشئ يجمع بلادنا غير الجغرافيا فيا لها من مفارقات حينما تجتمع الضفتان.
في شهر يوليو ٢٠٠٦م كنت اعمل في مكتبي في شارع (٣٣) بالعمارات في الخرطوم وكنا نحضر للإحتفاء بالذكرى الاولي لرحيل جون قرنق، بعد رحيله عم في أوساط الكثيرين الإحباط وساد الكساد، وذكرتُ للرفاق الذين يعملون معي ان طريقنا نحو استنهاض عضوية واصدقاء الحركة الشعبية يمر بالاحتفاء على نحو واسع بالذكرى الأولى لاغتيال دكتور جون قرنق، وان الناس سيأتون من كل الفجاج لحبهم له، واخترنا استاد المريخ الذي كان يسع حوالي ٣٥ الف شخص، وقد إمتلأ الاستاد على اتساعه وفاض الجمهور في الخارج بأكثر ممن استطاعوا دخول الاستاد، وكانت لحظة مؤثرة حينما أضيئت الشموع للإحتفاء بحضور قرنق مبيور في تسونامي الغياب.
ونحن في زحمة الإعداد جاءني احد الرفاق الذين يعملون معي، وقال لي ان هنالك امرأة وثيقة الصلات بثورة ١٩٢٤ تطلب مقابلتك، وكنت قد أبلغته إنني لا اود مقابلة أي شخص سوى المشاركين في الإعداد للذكرى الأولى لإستشهاد جون قرنق، وطلبت منه أن يأتي معها، قالت لي تلك السيدة: إنني قد جئت لاشكرك لأنك في كل اللقاءات الجماهيرية تتحدث عن ثورة ١٩٢٤ وعن قادتها وعن جدي أحد قادة ثورة ١٩٢٤، وقالت لي في حكي مدهش أن اسمها خديجة وقد ولدت وحيدة لأبيها جار النبي الذي ولد وحيدا لأبوه عبدالفضيل والذي ولد وحيدا لوالده الماظ والذي ولد وحيدا لوالده عيسى، وسألتها عن ابناءها فقالت انها الوحيدة التي ولدت مجموعة من الأبناء، أمضينا وقت ليس بالقصير معها في الحديث عن اسرتها وعن جدها عبد الفضيل الماظ وقلت لها غداً سنحتفي بالذكرى الأولى لجون قرنق واطلب منك أن تكوني ضيفة الشرف في هذا الإحتفال، فسالتني اين يوجد هذا الاحتفال، قلت لها في استاد المريخ، وسيحضره الوزراء ونائب الرئيس، فقالت لي كيف استطيع الدخول؟ قلت لها ستعطيني عنوانك وسيكون هنالك من هو في انتظارك لنذهب معاً، وجاءت معنا الي استاد المريخ، وفي خطابي أعلنتها ضيفة للشرف وعن إن جون قرنق قد عمل لإنصاف المهمشين وإنها وأسرتها قد تم تهميشهما وها هو جون قرنق في ذكرى غيابه الأولى يرد لها الاعتبار، وفي أي بلد آخر كان سيتم تكريم هذه الاسرة وسيكون لها شأن، وقد أبلغتني إن المعاش الزهيد الذي كانت تتحصل عليه قد تم إيقافه وطلبتُ في خطابي من نائب الرئيس علي عثمان محمد طه آنذاك ان يرجع معاشها وان يطلق على مستشفى العيون في شارع النيل إسم مستشفى عبد الفضيل الماظ لأن هذا هو المكان الذي عطره عبد الفضيل الماظ بعطر الوطنية دائم الصلاحية وغير القابل للنفاد، وفي خطابه وجه نائب الرئيس وزارة الصحة بإطلاق اسم عبد الفضيل الماظ على ذلك المستشفى، وشكري للسيدة خديجة عبد الفضيل الماظ فقد كان اللقاء معها ممتعا وجاء في لحظة كأن روح عبد الفضيل الماظ قد خططت لها، فقد قام بتحيتها وتحية عبد الفضيل الماظ عشرات الالاف داخل الاستاد وخارجه، فشكراً لهؤلاء الذين احبوا الوطن واوجعهم جميعاً.
في احدى امسيات عام ١٩٣٨ وفي نحو الساعة العاشرة ليلاً وفي مدينة شندي توقف قطار قادم من الخرطوم وقد كان في انتظاره رهط من اهل شندي لوداع اخر طبيب لبناني يسمى حسن سلامة الذي كان مقيما في شندي، وهو الذي كان عليه مغادرة السودان الي بلاده، حكى الأستاذ حسن نجيلة ان الرهط حينما اقترب من عربة الدرجة الاولي هالهم ان اسرع بالنزول جنديان مسلحان يحرسان العربة ويمنعان كل من كان على الرصيف من الاقتراب منها فدهشوا لذلك، نزل الدكتور سلامة ورأى الدهشة على من هم ينتظرونه في الرصيف يسالونه عما يجري، ذكر لهم ان سر استدعائه للخرطوم وعدم مغادرته من شندي ان طلب منه اصطحاب الزعيم علي عبداللطيف من محطة الخرطوم بحري حيث جيئ به من سجن كوبر بغرض تسليمه للمسؤولين في القاهرة بعد سنوات طويلة أمضاها في السجن متنقلاً من كوبر الي واو في ١٩٢٥ ثم عاد الي سجن كوبر بعد استشهاد عبيد حاج الأمين في سجن واو ١٩٣٢ بالحمى، وها هو علي عبداللطيف في عام ١٩٣٨ في طريقه للقاهرة.
22 يوليو 2018م
….. أواصل…..
بقلم ياسر عرمان
سودان تربيون.