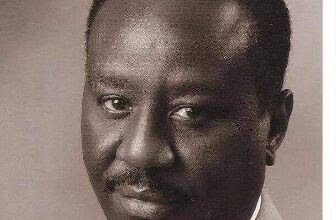السودان: هل انتقلت الحرب من السياسة إلى العرق؟

“سنقتلكم.. ونحتل بيوتكم.. وننتهك أعراضكم.. ونذبحكم على الهّوية لأجلكم والديموقراطية..”
– من دليل “الحشاشين” لصناعة فضاء سياسي ليبرالي سوداني عبر الخناجر المسمومة.
غسان علي عثمان
ghassanworld@gmail.com
إن التجربة الاجتماعية السودانية تتجلى أكثر في الفضاء السياسي، وكل من يريد البحث عن طبائع الأزمة وحدود الحل ينبغي أن يطرح على نفسه هذا السؤال: هل يمكن بناء نموذج تحليلي لصالح أي مجتمع دون الوضع في الاعتبار العلاقة الشرطية بين السياسي والاجتماعي فيه، بل لزاماً على كل من يسعى لتتبع الظاهرة السودانية من نشأة الدولة الحديثة حتى اليوم، أن يكون قادراً على الحصول ولو مبدئياً على إجابة عن العلاقة بين السياسي والاجتماعي في التجربة السودانية، وكيف انتهى المجتمع إلى كيان مسيّس يدخر كل جهده في الكلام في السياسة، ولا ينفق أقله في سبيل الإصلاح الاجتماعي والبناء الاقتصادي، ولا يستخدم من أدوات النقد والتحليل ما يعينه على تفهم طبيعة الظاهرة السياسية وملاحقة آثارها ذات الكلفة العالية، فإنه ومنذ ساعة رفع العلم الوطني وإنزال العلمين البريطاني/المصري وإلى يوم الناس هذا، لم يفتح الله علينا بعمليات بحثية تستنطق الأزمات وتبحث عنها ترصداً واستباقاً قبل تفشيها واستفحالها ورماً خبيثاً في جسد الأمة، ومن يصنع شريطاً سينمائياً للمشهد الدراماتيكي عندما اختلطت مشاعر السودانيين، سياسيين ومواطنين وهم يشاهدون استقلال بلادهم بعد حُكم أجنبي استمر لأكثر من خمسين عاماً، ويجترون ذكرى سنابك خيول كتشنر وهي تدنس أرض أم درمان، وعلى شريط الفيلم ذاته يتدفق أكثر خلاص الوجوه المؤقتة حين وقف الأزهري ومحجوب يرسمان ابتسامة اتسعت لها كل شفاه السودانيين، ومن حينها فإن الكثير قد جرى لهذه البقعة من جغرافيا العالم والتي أعيّت المحللين عن فهم الأسباب الرئيسة التي أقعدت ببلد واعد يملك من مقومات الاستقرار والتطور ما يجعله في منطقة من التنمية أرضاً وإنساناً أفضل بكثير من حصادنا المر حتى اليوم، أترى أين العلة؟..
بطبيعة الحال إن كان أحد يملك إجابة شافية عن الأسباب الجوهرية للأزمة السودانية فحتماً أنه لا يعرف فيما يخوض، أو يركن للسطحي من المشكلة، والسبب أن فرداً مهما بلغت به مراقي التنظير والحساسية الفكرية ليس بقادر وحده على استجلاء أسباب الأزمة، فقد انتهى عصر الخوارق والكاريزما وازدهر عصر المؤسسات، ولذلك فإننا هنا لا نصدر إلا عن محاولة تنضاف إلى أخريات للاقتراب أكثر من فحص الجيْن المتعفن في جسد السودان، وهو المسؤول عن وقائع الخراب التي استعلت للدرجة التي باتت معها أي محاولة للفهم أشبه بالبحث عن رماد وسط بركان هائج، لعلنا نضيف لو سطر واحد لركام التحليلات الساعية إلى فهم هذه السردية التي يبدو ألا نهاية لها بسبب تطاول المشكلات وتراجع الحلول.
إن أولى المداخل الصحيحة لفهم المشكلة هي البحث عن مصدر المقولات، ولأننا نقول بأن السياسة ما هي إلا لحظة من لحظات الظاهرة الاجتماعية لذا فإن مصدر أزماتنا ثقافي، فجملة التصورات السياسية تستند إلى فهم هوياتي قبل كل شيء، فالهوية الثقافية المرسومة في ذهن السودانيين جزء من مشكلة فهم الواقع الاجتماعي، إذ ظل الحديث يدور حول (التباين- الاختلاف – التمازج…إلخ) وانصرف أغلبه إلى إقرار حقيقة التباين العرقي والثقافي بين سكان السودان، ومنهم من انتهى إلى وجود ثمانية أقاليم ثقافية هي جِماع هذا التكوين وهي: (1. ثقافة سكان ضفاف النيل، 2. ثقافة سكان السافنا، 3. ثقافة إقليم البجا في شرق السودان، 4. ثقافة الفور، 5. ثقافة النيليين بجنوب السودان، 6. ثقافة الزاندي السودانية، 7. ثقافة إقليم جبال النوبة، 8. ثقافة المابان بجبال الإنقسنا في جنوب النيل الأزرق- راجع: محمد عمر بشير – التنوع والاقليمية والوحدة القومية، ترجمة سلوى مكاوي، سلسلة ثقافة للجميع، مصلحة الثقافة، 1980م، صفحات 26 – 27.).
تسهم مثل هذه النظرة في تعميق الحدود العرقية بين السودانيين، لأنها تتجاوز فكرة التعايش والاندماج والتداخل ووحدة الوعي، ولعل الخطابات العنصرية التي يقدمها بعض من يدعون تمثيلهم لأبناء أقاليم بعينها وهم من لم ينتخبهم أحد للحديث نيابة، ولا فرق بينهم وبين بقية “النخبة” السودانية فالجميع هنا ينطلقون من قاعدة أن السياسة هي الطريق الأقرب لإصلاح معاشهم هم ومن يوالونهم، وهذا الخطاب العنصري يكشف إلى حد كبير عن فاعلية في الحرب الدائرة إذ يخاطب العواطف القلقة لا الوعي، والحرب الدائرة الآن وإن بدأت في سياق العنف والعنف والمضاد، في سياق عنف الدولة والتدافع على السلطة، والسعي الحثيث لاستخدام القوة للحصول على الشرعية فإن ما ظلننا نسمعه من بعض من يقدمون أنفسهم محللين ينتمون للدعم السريع يكشف عن طبيعة التحولات التي صاحبت الخطاب السياسي للحرب في السودان، وتتبعاً للخطاب السياسي منذ بداية الحرب وحتى الآن، فالأمر بدأ محصوراً في سياق الصدام العسكري بين قوتين فشل العقل السياسي في التنبوء به، وبعد أن فشلت الخطة (أ) في الاستيلاء على السلطة تغيّر الخطاب السياسي من الصراع بين طرفين إلى الحديث عن المظالم التاريخية التي صنعت الأزمة، وهنا ظهرت الخطة (ب) والتي وجدها المتحدثون باسم الجرائم والانتهاكات جاهزة في قوالبها ومعدة للاستخدام، ولذا برّع الناطقون في استخدام هذه المقولات لإيهام الرأي العام والعالمي بأن هذه الحرب نتيجة لما ظلت تقترفه النخب النيلية في حق (أبناء الهامش) ومن ذلك مقولاتهم حول (دولة 1956م- دولة الجلابة- النيل والغرب إلى آخر المونولج المعبأ بالصدى) فالقتل والاغتصاب وانتهاك الحرمات واحتلال مساكن المواطنين وتهجيرهم مقبول لدى هؤلاء، وهو نتيجة طبيعية لما عاناه (الهامش) من ظلم الوسط النيلي، ومعنى ذلك أن هذه الجرائم مقبولة ومعقولة بل وواجبة طالما أنها ليست سوى ردة فعل على ظلم متعاظم أصاب أطرافاً سودانية بفضل تهميشهم وإبعادهم عن السلطة والثروة من قِبل مجموعات قبلية تنتمي إلى الوسط والشمال، وكأن الخرطوم أو الجنينة أو أي منطقة جرى فيها عنف هؤلاء ما هي إلا محميات طبيعية تعيش فيها حيوانات نادرة، وليست مدن بالمعني السيسولوجي أي أنها وحدة حضرية تكتط بالسكان، وساكنتها لا ينتمون إلى عرق واحد، إذاً هذا التبرير الخطير والمجرم لا يخدم إلا أهدافاً مؤذية تصدر عن وعي موبوء.
لنعد للخطة (ب) والتي كما قلنا عادت لتستثمر في مقولات ظلت محل استخدام أعمى لكنه منتج في نظرهم ونظر من يوجهون إليهم خطابهم، وقد فعلها جون قرنق من قبل في حربه ضد الشمال باسم النضال لبناء “السودان الجديد” وإن كان جون قرنق صاحب رؤية يسعنا عبرها فهم أهدافه الثقافية من الحرب، وقرنق كان واعياً جداً حينما فرّق بين صراعه مع المؤسسات وموقفه من المجتمع نفسه، وقد جرى تطور كبير في خطاب الحركة الشعبية بحكم تراكم التجربة السياسية والعسكرية، وكذلك يعود الأمر إلى قدرات جون قرنق الشخصية كونه صاحب ناطقية واضحة وبيان متسق فيما يعبر عنه، لكن الاستدعاء هذه المرة يأتي على يد أدعياء يرددون مقولات منزوعة من سياقها، مثل قولهم: (هيمنة الأقلية على الدولة، التهميش من قِبل الجلابة) وهو تصور يستبطن معنى عرقي يمتح بالعنصرية التي يتهمون بها الطرف الآخر، وواقع الحال يتعجب المرء هل اكشتفت جرائم الجلابة فجأة بعد الاتفاق الإطاري؟ هل كان الجيش الذي يحاربونه الآن مؤسسة سودانية جمعت كل أطياف هذه البلاد، وفجأة بات مؤسسة تمثل الجلابة فقط؟ هل سكان الخرطوم تحولوا فجأة إلى أعداء كونهم “ينعمون” بالخيرات التي حرم منها أبناء الهامش؟ والسؤال الأهم، إلى من يوجه هؤلاء خطابهم؟ أهو إلى “جماهير شعبنا” كما يرددون؟ شعب من الذي يود المجرمون إرسال خطابهم إليه؟ وهل سيقبل الشعب السوداني كله بقبائله جميعاً أن يكون لهؤلاء وجود مستقبلي؟ لم نقع على غباء مقدس بهذا الشكل في كل الصراعات التي دارت في الخرطوم، ثم أن هذه الأقلية المُجَرمة ليست عرقية من الأساس، بل هي تجمع انتقل برافعة التعليم من موقع القبيلة إلى موقع الدولة النخبوية، وهؤلاء أول ما انصرفوا عنه هو التعبير عن مصالح طبقتهم الاجتماعية، ولذا فإن اتهامهم لا يمكن أن يدفع بأصحاب خطاب (التهميش) إلى تجريم كل البنية الاجتماعية التي ينتمون إليها، وبحق لا يريد أن يصرح هؤلاء بأن مشكلتهم ليست مع من يجلسون في القصر الجمهوري بل مع أعداء مفترضين يتمثلونهم في القبيلة والعرق، وإلا بماذا تفسر تبرير العنف الذي نعيشه من جانب المغتصبين اليوم، فخطاباتهم تضج بمعاني عنصرية، وأنهم في سبيلهم لإنهاء دولة الجلابة.
إن الشيء الذي ينبغي ألا نتهرب منه هو أن خطاب التهميش والمظلومية انتقل من كونه خطاب سياسي يستند على تجليات في التاريخ والواقع إلى خطاب (عنصري) يتقدم به البعض لصالح تحشيد يستند على القبيلة والعرق والإقليم، وتحويل مسار الحرب من العنف السياسي الصِرف إلى عمليات نضالية انتقامية يقوم بها “رُسل الديموقراطية” لصالح بناء دولة الرفاه والمواطنة، وسبيلهم لذلك استخدام سلاح العرق في تصفية الجاني المتوهم، ويريد هؤلاء ولإنقاذ أنفسهم أن يصيغوا مشروعاً سياسياً يشتغل حثيثاً على إسناد عرقي، ولكن لخيبة ما سيصيب أصحاب هكذا المشروع أن هذا السودان يستطيع أهله التعايش وفق صيغ من عدالة اجتماعية لا تستند على العرق والقبيلة بقدر ما استنادها على إصلاح اقتصادي يوفر للجميع حقوقهم في السودان.
إن المسألة في حقيقتها تعود إلى الخلل الاقتصادي صانع الغبن التنموي في السودان في أقاليم الشرق والغرب والشمال والوسط ، فالسودان كله يعاني من هذا الاختلال، وليس من صعوبة أن تسافر إلى أي مدينة سودانية وفي أي اتجاه لتلمس هذا الغبن لدى المواطنين، إن هذا الخلل هو الأرضية التي انبنت عليها أسس هذا الخطاب (خطاب التهميش)، ولكن انصرف المشتغلون على تصدر المشهد السياسي إلى صياغة لائحة الاتهام ونسبتها إلى أبناء الشمال والوسط، رغم أن حقيقة أن الذي جرى في سوداننا منذ الاستقلال وحتى الآن وفي عين فاحص أمين يقود إلى تحليل آخر ينتمي إلى السياق الاقتصادي/الاجتماعي الذي مكّن لأقلية ليست عرقية وإنما يصح وصفها بـ(الفئة) وليس (الطبقة) هي فئة المتعلمين الذي تشكلت ذهنيتهم بقصور واضح تجاه القضية الوطنية، فـ(الأفندية) الجماعة التي استولت على مفاصل الدولة السودانية عقب الاستقلال اجتمعوا على معنى (الامتياز الحضري) ولم يعقدوا تحالفهم غير المعلن على أسس من انتماء عرقي ثقافي أو حتى أيديولوجي، نعم، اتفق أنه ليس من المعقول الاستمرار في التعميّة، والقول إن هناك عدالة تنموية تساوي بين أقاليم السودان، ولكن الحقيقة أن الأمر ليس على هذه الشاكلة، فالذي لدينا هنا هو اختلال بين الريف والحضر، هو غياب سياسات التنمية المتوازنة للمناطق الريفية والحضرية، والمشكل لا يستند على معنى عرقي، ولكن يبدو أن من يسعون لتسيير عمليات نظرية في هذه الحرب يريدون أن يُركبوا معنى عرقي/إثني ضد أقاليم السودان المختلفة، والحقيقة الاجتماعية أن السودان يعاني من أزمة في الهوية وخلل في التنمية، وانهيار في المؤسسات.
لكن ترى لماذا يلجأ العنصريون إلى استخدام مسألة (الهامش والمركز) في الصراع الدائر اليوم؟ الإجابة ببساطة أن هذا السلوك يراهن على التوسل في سوق القيم الإنسانية الرائج الآن، فمتى ما وضعت ديباجة (العنف الثقافي- التهميش الاقتصادي – الأقليات الشرسة) واستدعيت تاريخ الرق والعنف الاجتماعي فحتماً أنك واجد من يستطيع مدك بالسند والتأييد لرأسمالك الرمزي والذي ينقلك من موقع الجاني إلى الضحية.
إن من متاعب الانتقال بالسياسة من الحرب إلى العرق هو تفكيك البنى التي يدعي أصحاب خطاب (التهميش بالعرق) الانتماء إليها والدفاع باسمها، لأن عامل العرق لديه قابلية الهيمنة على الخطاب، ولذا فإن كان الشمال أو الوسط النيلي يشكل عدو اليوم فإن متاهات التحليل العرقي في السياسة ستكون قادرة على صناعة الأعداء من داخل التكوين الاجتماعي الذي تتحرك منه، وبذا فإن عملية تكاثر ذاتي ستنشأ في حال الاستسلام لخطاب العرق، اليوم الشمال والوسط والنيلي، وفي الغد (زرقة) دارفور، أو (عربها) ثم (كردفان) ومنها (النيل الأزرق) و (الشرق) ووو..
كما أنه ليس صحيحاً أن التكوين الاجتماعي لمن يطلق عليهم (الجلابة) في تماسك للدفاع عن نفسه، فالجغرافية الثقافية للوسط النيلي ليست بنى متراصة أو مصطفة بل هي نتاج تداخل عرقي وثقافي، لأن الذي يصنع أي جماعة ثقافية هو تنوع مصادرها وتعددها وليس واحديتها، وهنا فالرهان على التحليل العرقي خاسر طالما استقر لديك وهم خلو أي بنية اجتماعية من عمليات التماهي مع بنى أخرى، كما أن عامل العرق معقد ومكلف في سياق التحليل الاجتماعي لأنه يشترط وجود حالات غير متماسة مع الأخرين، وهنا فإن خطاب (التهميش بالعرق) خطاب مغلق وحال استنفد أغراضه وأنحلت عراه سيظل يبحث عن المظلومية باستمرار خبيث، ومتى بدأ العمل على تجفيف مصادر التهميش تحرك الخطاب بصورة غير واعية ناحية البحث عن روافع أخرى لا تنتمي إلا إلى التشيؤ كضحية خالدة.
وحتى لا تنجرف الحرب من السياسة إلى العرق ينبغي العمل على إيجاد المداخل الصحيحة للمشكلة السودانية هذا إن كان في نية المتصارعين على السلطة البحث عن حلول وليس الاستثمار اللامحدود في الأزمة ومظاهرها، وهنا وجبت العودة إلى سؤال المواطنة والذي يتهرب منه الجميع، وللإجابة عنه فإننا نقول بأن السياسي الذي يصدر فعله على التبرير لا التحليل، والذي يتكسب من حضوره السياسي ولا يعرف موقعه في الظاهرة، ويستقر في وعيه أنه (مناضل) ولا (فاعل اجتماعي)، ويظل يعمل في جَد يحسد عليه لأجل تسمية حضوره لا من خلال إطروحاته وإنما عبر حنجرته وبلاغته المستأجرة، فهنا فإن أول ما يحتاجه السودانيون أن يبحثوا عن الطريقة المثلى لتحرير الوطن من السياسي بائع بضاعته من الأناقة والحكي، إلى السياسي المتقن لدوره كونه وسطاً بين القول والفاعلية، وقد سئم الشعب من السياسي القادر على ابتلاع كل شيء في جوفه دون أن يدفع ثمن لذة الاستماع بالسلطة والحديث باسم الجماهير، إن دعوتنا بسيطة وهي خالصة لوجه الوطن أن نترك التحايل على الأزمة ونخاطبها على هدى حقيقتها، فأزمتنا ليست مشكلة عرقية، أو استعلاء ثقافي، أو تهميش بالعرق إن مشكلتنا تتلخص في غياب الفاعل السياسي المنصت إلى أحلام شعبه والقادر على الإخلاص لا المتاجرة، وحتى يحدث هذا فإن الحرب الدائرة الآن وعلى أي شاكلة انتهت فإنها لا تصلنا بالطريق الصحيح للنجاة بل لعلها ستزيد من تعقيد الأزمة لأن جوهر المشكلة لم يتم البحث عنه، وظللنا نحلق في فضاء التبرير والإشارة والتعليق، ولعل أسوء ما يمتلكه العقل السياسي السوداني أنه ينفق جهده في البحث عن المقدمات لا النتائج، يشغله إثبات وجهة نظره لا الحقيقة الماثلة أمامه، وهو بهذه الطريقة في التفكير المعّوق لا قبض على المجرم، ولا استطاع إنقاذ الضحية من الموت.
غسان علي عثمان