عندما رحل الوزير غلام الدين عثمان آدم
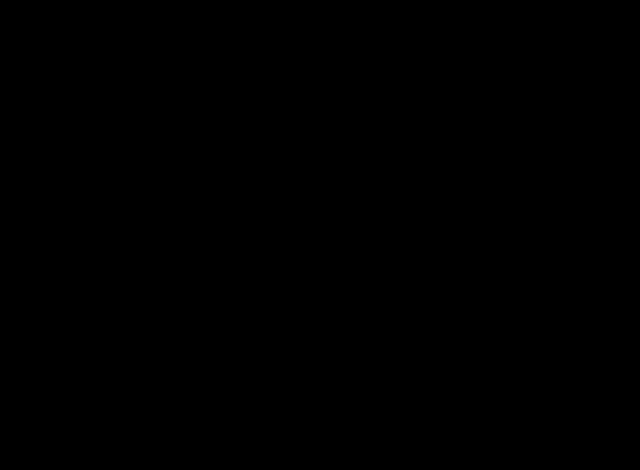
أنعي إليكم شقيقي العزيز، الوزير الإنسان، غلام الدين عثمان آدم، الذي رحل عن دنيانا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل والإخلاص.
حينما علمت بالوعكة الصحية المفاجئة التي ألمّت بشقيقي غلام، شددت الرحال إلى القاهرة برفقة أخي عبد الشافع، وقضينا معه قرابة أسبوعين. كانت تلك الزيارة بمثابة دفعة معنوية كبيرة له، كما شهد بذلك كل من حوله من الأهل والأصدقاء.
وفي مطلع يوليو، وبعد مغادرتي القاهرة، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إشاعة عن وفاته. لكن غلام الدين نفسه بدد تلك الشائعة برسالة صوتية طمأن فيها الجميع عن تحسن حالته الصحية.
وفي مساء الأحد، السابع من سبتمبر، تحدثت إليه هاتفيًا، وأكد لي أن الطبيب بدأ في تقليل جرعات العلاج بعد زوال معظم الأعراض. بدا مطمئنًا ومتفائلًا.
لكن في صباح الاثنين، الثامن من سبتمبر، وبعد ساعات من تلك المكالمة، انهالت عليّ رسائل التعزية من الأصدقاء والمعارف. ظننتها إشاعة جديدة، امتدادًا لتلك السابقة، وتوقعت أن يدحضها غلام كما فعل من قبل. غير أن رسالة من أخي غالب حملت لي الخبر اليقين: غلام الدين قد رحل.
كونه شخصية عامة، عجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالمقالات التي تناولت سيرته ومناقبه، كتبها أصدقاء وزملاء عايشوه في مراحل مختلفة من حياته، منذ أن كان طالبًا بجامعة أم درمان الإسلامية، وحتى تقلده المناصب العليا كمدير ووزير ووالي. تحدثوا عن تواضعه، كرمه، كفالته للأيتام، وإخلاصه في أداء واجبه.
أما أنا، شقيقه الأصغر، فسأحدثكم عن غلام الطفل، غلام الصبي، الذي تجلت فيه تلك الصفات منذ نعومة أظافره.
نشأنا سويًا في بلدة دارمالي بولاية نهر النيل، شمال عطبرة، حيث محطة القطارات. كنا ننتظر قطارات البضائع بشغف، إذ تُركن لعدة أيام، وخلالها يقوم عمال الصيانة بإخراج خيوط ملونة مشحمة تُستخدم لتزييت العجلات، ثم تُدفن في الرمال. كنا ننبش تلك الخيوط، ننظفها، ونجففها تحت الشمس، ثم نحملها لغلام، الذي كان يصنع منها “هبابات” مطرزة بإتقان. كنت في السابعة من عمري، وهو في الحادية عشرة. كنا نبيع تلك الهبابات لركاب القطارات، وكان غلام يحتفظ بنصف الإيراد ويمنحنا النصف الآخر.
ثم نراه في لوحة أخرى من الطفولة، يحمل البرسيم من الحقول البعيدة، يرتبه في ربطات متناسقة، ويبيعه على الطريق العام، ليعود محمّلًا بالحلوى لنا نحن الصغار.
وفي لوحة ثالثة، يجمع ألياف وسعف النخيل من جنينة “على أفندي”، يبلها بالماء، ويفتلها ليصنع منها الحبال التي تُستخدم في شتى الأغراض.
وفي لوحة رابعة، يعمل غلام صبيًا لدى ميرغني حفّار الآبار، ويساهم بما يكسبه في إعالة الأسرة وتوفير مصاريف المدرسة.
ومن المواقف التي لا تُنسى في حياة غلام، والتي تشهد على نُبله وتقديره للمسؤولية، أنه كان يقتطع من نثرياته الجامعية، رغم ضيق ذات اليد، ويرسلها للأسرة في دارمالي. كان يعلم أن معاش والدي، رغم اجتهاده، لم يعد يكفي بسبب موجات التضخم التي ضربت البلاد آنذاك، فآثر أن يتقشف في غربته الجامعية ليضمن لأهله في الوطن ما يسد رمقهم.
كان غلام طالبًا بجامعة أم درمان الإسلامية، يعيش في سكن متواضع، ويكتفي بأبسط الوجبات، فقط ليتمكن من إرسال جزء من مخصصاته الشهرية إلى والدتي، التي كانت تدير شؤون البيت بحكمة وصبر. لم يكن ذلك واجبًا مفروضًا عليه، بل كان نابعًا من إحساسه العميق بالانتماء والواجب، ومن قلبٍ لا يعرف إلا العطاء.
أتذكر جيدًا كيف كانت والدتي تفتح الرسالة التي تحمل النقود، وتدعو له بحرارة، وتقول: “غلام ما بنسى أهله”. وكان ذلك الدعم، رغم بساطته، يُحدث فرقًا كبيرًا في حياتنا اليومية، ويمنحنا شعورًا بالأمان وسط تقلبات الحياة الاقتصادية.
ذلك هو غلام الذي لم ينتظر أن يصبح وزيرًا ليعطي، بل بدأ بالعطاء منذ أن كان طالبًا، يشارك أهله ما يملك، ويُشعرهم أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة الحياة.
كل هذه الصور من طفولته تتطابق تمامًا مع ما ذكره زملاؤه من صفات: الإتقان، الإخلاص، الكرم، والعطاء.
رحمك الله يا غلام، فقد كنت مثالًا للإنسان النبيل منذ الصغر وحتى آخر لحظة في حياتك.
غانم عثمان آدم – كندا







