مبادرة الجد والهزل: ابتذال الصوفية لدواعٍ انتهازية
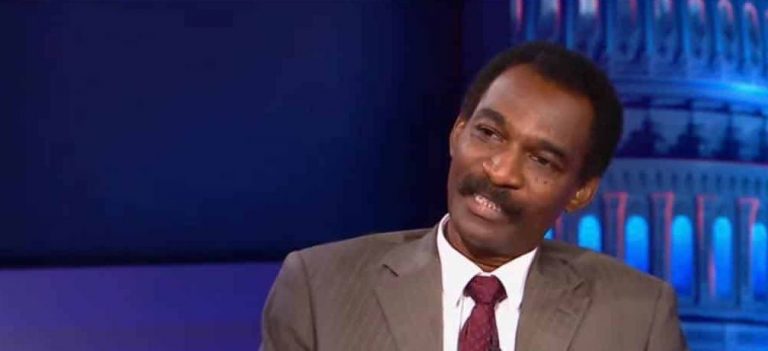
صلاح شعيب
النهج الصوفي في شموله يستلزم التخلص من ثقل الحياة بمزيد من العمل الروحي العرفاني، وإتقان الإحسان، وتنمية مقامه، فضلاً عن تربية خصيصة النفس، ولجم رغائبها بتقوية التوكل على الله، والتطهر من سخائمها. وذلك المفهوم هو، تقريباً، ما نشأت عليه الصوفية السودانية، إذ هي عماد مجتمعنا السوداني بشقيه المسلم، والمسيحي، والكجوري، وهكذا دواليك.
وإن لم تقتصر كفعل روحي جمالي على مسلمي البلاد فحسب، فالصوفية كانت كذلك موظفة عند مكوننا اليهودي الذي هاجر في ملابسات احتلال فلسطين، وأهل المسيحية، وكريم معتقداتنا، تمارسانها بأرواحيتها، وطقوسها، بشكل أدعى للاقتراب من هالة الصفاء الروحي. وقد ظل هذا هو ديدنها إلى أن غشت الصوفية في الثلاثة عقود الأخيرة طائفة من ممارسات دينية شكلانية جديدة تدنو من الالتحام مع السياسي الذي يشرك لطيور شيوخها حتى إن ركت في محفل الدنيوي ذي الصلة بالسلطة بارحت أهم مزايا مقولاتها القيمية التاريخية: “الدنيا جيفة، وتركناها لكلابها”، كما أفصح صوفيون بحدة.
سوى أن المقولة لا تعني اعتزال الصوفيين الدنيا، وإنما في مسيس حاجتهم إلى تحقيق الشفافية الروحية يؤكد هؤلاء المتصوفة بأن الفعل الصوفي في الأصل خالص لله، مخاصماً للالتحاق بقطار الواصلين إلى الإمتاح من بئر التورط في تقاطعات الانتهازية الدنيوية التي تسيل لعاب البشر عند المحكات العظيمة حينما تلوح سوانح المغريات أمام ساحة القلب.
بخلاف الصوفيتين الأنصارية والختمية، تنطرح المشيخات الصوفية – غير المسيسة – في فضائنا المجتمعي لتشذبه بسلك الطريق القويم، والمديح الذي يرطب المكان، ويحيطه بأريج النقاء في الحضرة لترتقي النفس في مدارجها كي تبلغ سلامها الداخلي. وفي هذا تعددت المسالك عند مكونات صوفيتنا لتخلق تنوعاً بديعاً شكل رباطاً قوياً لمجتمعنا السوداني بعضه يشد ازر بعض، متى ما ترك قادتنا السياسيون أمر تجيير هذه التنويعات الصوفية ضمن محصلة الصراع الدموي حول السلطة، ومتى ما سلمت هي نفسها من مشيخات تجعل من مرتبتها الروحية بازارا للشراء.
مفهومٌ جداً بروز البهلوانية الجديدة لمشيخات الصوفية السلطانية التي تعتقت مصالحها الدنيوية في زمن الإنقاذ، وبعض الأفراد الذين حولوا حوليات الصوفية المختطفة إلى مهرجان يشع بثراء منظميه – لا بالزهد الذي تعارفنا عليه – وكذا تتحول سيماءات الصوفية إلى مجرد أزياء مزركشة، وتقليعات، وشكلانية في التعبد.
فالطفيلية الرأسمالية التي تتخفى خلف سلطاتنا منذ الاستقلال تدرك أن لا منجاة لها من حتمية التغيير الذي يعيد أمور السياسة إلى نصابها. ولهذا فإنه كلما استحكمت الحلقات حول هذه السلطات المجتمعية القابضة دنت أكثر من الصوفية لإنقاذها من حرج ذاك السؤال المجتمعي الملح حول إمكانية قيام الحكم الرشيد.
ويتذكر الناس في نهايات النميري كيف أن الملاذ الأخيرة له كان البحث عن خلفيات صوفية تُهجع سهر قلبه الملتاث من فقدان السلطة فسعى لمشيخات معينة تحيطه بمعصم الحماية، وتدعو له ليل نهار لكبح تآمر الناس على حكمه العضوض. وحينذاك لا يستنكف الرئيس الإمام من أن يجلس مع دجالين صوفيين ليكشفوا له بالتعاويذ، والتمائم، أسماء هؤلاء المتآمرين، ولا ينسى أن يطلب منهم التنبؤ بعدد سنين بقائه.
ولاحقا أحيت الإنقاذ تلك السنة، وحشدت المشيخات الصوفية بالترهيب، والترغيب، عبر مؤتمر “الذكر والذاكرين” في حديقة الحيوان لدعمها في مهمة إعادة الصياغة، ومساعدتها بالجن ما أمكن لتفجير ثروات البلاد. ورويداً، رويداً، تمكنت من اختراق كثير من هذه المشيخات، وخلقت أخرى لتكون طوع بنانها حتى تجلب لقادتها العسل من السماء. وفي ذات الوقت تعيد هذه المشيخات طمأنتها بعدد سنواتها الممتدة في السلطة. ومع ذلك كان بعض أدعياء التصوف السلطويين يحتاطون إذا ما خاب توقعهم بالقول: “والله يضاعف لمن يشاء”.
في هذا الجو كثر المتطفلون الذين اختطفوا الصوفية ليوظفوها لأنفسهم بعد أن دخل بعضهم نادي الرأسمالية الطفيلية، ورأى الناس أن الشيوخ الجدد إنما هم الممتطون للعربات الفارهة، ويتابعون تجارتهم في دبي، وماليزيا التي انفتحت لهم، بكثير من إتقان التعامل مع التكنلوجيا. والأكثر من ذلك غابت صورة الشيخ الزاهد، وحلت محلها صورة الشيخ البزنس مان، ذاك الذي يرتدي الساعات السويسرية، والخواتم الياقوتية، ويحنن النساء، وينتخب شكل آخر التسريحات، والبدل الباريسية حتى لكأنه يفتينا بشكل مباشر بأن لا علاقة للزهد بالصوفية الحديثة.
مؤخرا وقفنا على مسرحية مبادرة الشيخ الصوفي الجد الذي ورطته الرأسمالية الطفيلية، وسلطة الانقلاب، وجماعات من الإسلام السياسي في حبكة درامية بمساعدة حميمة من الإسلاميين نيام، وأبو قردة. ويبدو أن الرجل – مهما كانت دوافعه الطيبة، أو الخبيثة – فقد وقع في مخططات هذه الجهات المتضامنة من خلفه لتضعه في الواجهة وتتحكم على الروبوت من تركيا، حيث فرغت طيبة برامجها لتغطي فاعليات المبادرة. وحتما لن يكون الجد هو الأخيرة فقد سبقه أبو قرون الذي صور للنميري أنه يستطيع الطيران، وعبد الجبار المبارك، والشيخ الأمين، وبله الغائب، وهناك آخرون من لدنهم، وما بدلوا تبديلا، وغشيهم الجوكية نعاساً.
السؤال الذي يطرح نفسه في ملابسات استناد الإسلاميين بالصوفية الآن لإعادة مجدهم في التنعم بالسلطة هو أين موقع أدبيات الحركة الإسلامية من التصوف في شقه السوداني الإسلامي؟ فنحن نعلم أن هذه الأدبيات تقوم على احتقار دور التصوف عموما إن لم تجعله متورطاً في وضع الدين على رف الحياة. وللترابي تنظيرات، وشفاهيات، يحط خلالها من قدر المشيخات المتصوفة السودانية، ويصفها بأنها متواطئة تاريخيا مع الاستعمار، والسلطات الوطنية، في تهميش دور الدين في الدولة. ومع ذلك خسر مشروعه الدين والدولة وبقيت الصوفية السودانية النزيهة جوهرا من جواهر التماسك الاجتماعي السوداني، ومنتجعا لطائفة واسعة من مواطنينا ينشدون فيه الصبر على ما جنته الحركة الإسلامية في إفقار معاش الناس، وتمزيقهم للمجتمع، وتهديدهم للأمن ، وإفسادهم لمعاملات الدين والدولة معاً. بل بقيت نار الصوفية متقدة يتلى حولها القرآن الكريم فيما بارت تجارة الإسلام.
صوفيتنا السودانية بتنوعاتها المتعددة تمثل واحدة من أعمدة تضام النسيج الاجتماعي، وقد صهرت الانتماءات العرقية، والجغرافية في حوزاتها، إذ فيها يتضوع مسك المديح النبوي، وتكون التكايا ملمات لتلاوة القرآن الكريم، وللاقتراب من نور الله، وكذا يبقى الذكر الخالص له مشحونا بالإلفة الروحية حيث هناك تشفى القلوب، وتتواسى، وتتصالح. وهكذا ستظل الصوفية السودانية عصية أمام محاولات إعادة عقارب الساعة إلى الوراء مهما سعى الانقلابيون، والإسلاميون، والانتهازيون، لدفع بعض الشيوخ إلى مقدمة المواجهة مع قوى التغيير نيابةً عنهم.
صحيفة التحرير







