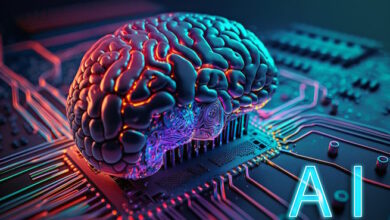أرض الذهب والماء.. لماذا يجوع السودان؟

على ضفاف النيل في مدينة خرطوم الشمال، والمعروفة باسم “الخرطوم بحري”، الواقعة شمال العاصمة السودانية الخرطوم، يطل مبنى ضخم حديث مكون من ستة طوابق يُغلفه زجاج أزرق عاكس مع أرضيات رخامية فاخرة، ويبدو المبنى للوهلة الأولى أنه أحد مباني سلسلة فنادق عالمية، إلا أن المبنى الفائق الفخامة هو في حقيقة الأمر أحد المستشفيات الخاصة السودانية المنشأة حديثًا تحت اسم “يونيفرسال السودان”.
لم يكن ذلك المستشفى عاديًا في أي وقت أو يمتلكه مستثمرون عاديون في القطاع الطبي السوداني مثلًا، وإنما يديره أفراد متقاعدون في جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، محتويًا على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. ورغم أن تجهيز إحدى المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة في أي دولة يعد أمرًا اعتياديًا طالمًا توافرت الإمكانيات المادية، إلا أن هناك مكان واحد لم يُسمح له دوليًا بذلك ولو توافرت الموارد، لذا عُد تجهيز مستشفى بجميع الأجهزة الطبية الحديثة أمرًا مستغربًا حينما يكون مقامًا على أرض دولة كالسودان، خاصة في ظل عقوبات أمريكية سابقة حولت المستشفيات الحكومية، التي تبعد عدة كيلومترات عن يونيفرسال، إلى مساكن أشباح وأطلال لصعوبة الحصول على أجهزة طبية أو قطع غيار من أي نوع.
في خضم ذلك، أشارت وثيقة حصلت عليها وكالة بلومبيرج(1) -في أكتوبر/ تشرين الأول للعام الماضي 2017- من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، التابع لوزارة الخزانة الأميركية والمخول بمراقبة ومنح التراخيص للشركات الأجنبية التي تريد إجراء معاملات مع دولة تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات سارية مثل السودان قبل رفعها في التوقيت المذكور، أشارت إلى أن شركة “GE Health care” الأميركية -عملاق تصنيع المعدات الطبية- قدمت عرضًا في مارس/آذار عام 2016 لتوريد أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة تصوير مقطعي وغيرها من المعدات بقيمة 25 مليون دولار إلى مستشفى يونيفرسال، وحينما سُئلت الشركة عما إذا كانت على علم بصلة المستشفى بالنخبة الحاكمة السودانية، امتنعت عن التعليق. ولم تكن “GE” -ذات القيمة السوقية القريبة من 20 مليار دولار- هي الوحيدة، لنجد أن الوثائق قد كشفت أيضًا عن توقيع الشركة السويدية للمعدات الطبية “إلكتا” عقدًا لتوفير معدات العلاج الإشعاعي لقسم الأورام بـ “يونيفرسال”، إلا أنها أكدت في بريد إلكتروني على أنها لم تكن على دراية بارتباط المستشفى بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني.
تعطي الحادثة السابقة ملمحًا هامًا عما يدور في المشهد الاقتصادي السوداني منذ سنوات طويلة، وهو مشهد ذي طبيعة عربية أصيلة، حيث سيطرت عدد من دوائر النخبة الحاكمة،، على مقدرات الاقتصاد الذي خرج من تحت عقوبات دولية جثمت عليه منذ عام 1997، مستأثرة بكل ما يمكن أن يوضع في صورة استثمارات فائقة ومربحة مقابل اقتصاد منهار في أغلب قطاعاته الشعبية تحديدًا.
ورغم أن العقوبات قد تم رفعها نهاية العام السابق فقط، إلا أن آثار هذا المشهد لم تلبث أن تسببت بشكل شبه مباشر في اندلاع احتجاجات، ربما أتت متأخرة- في العديد من المدن السودانية، مثل الخرطوم وعطبرة والقضارف وأم درمان وشمال كردفان وغيرها، منذ أيام قليلة، وهي احتجاجات أتت ردًا على ارتفاع أسعار الخبز والوقود(2) ولم تتوقف حتى تلك اللحظة، ونتج عنها مقتل حوالي 10 أشخاص، حسب مصادر رسمية، بينما يأتي رقم 22 سودانيًا للآن حسب “الصادق المهدي” رئيس حزب الأمة المعارض، وعشرات الجرحى والمعتقلين، وأيضًا إحراق مقار عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، من بينها مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
لطالما كان الاقتصاد السوداني، تحت وطأة عقوبات طالت لـ 20 عامًا ونخبة حاكمة استحوذت على أجزاء الاقتصاد القليلة الفاعلة وأرباحها، لطالما كان ذلك الاقتصاد أحد أضعف اقتصادات القارة أداءً تبعًا لظروف اقتصادية لا يمكن عزوها بطبيعة الحال للسودانيين أنفسهم، والبالغ تعدادهم نحو 40 مليون نسمة، لذا، كان متوقعًا للأزمة الاقتصادية والمالية الطاحنة أن تنتج طال الأمد أم قصر احتجاجات واسعة كتلك في ظل تردي أوضاع معيشية لا يتوقف، إلا أن نظرة على تفاصيل إدارة تلك النخبة للمشهد السوداني الاقتصادي ربما يكشف نقاطًا أهم يمكن أن ترسم مسار الاحتجاجات الحالية ومستقبلها.
بموجب اتفاق السلام المُوقع عام 2005، فقد انفصلت ولاية السودان الجنوبية لتشكل جمهورية جنوب السودان عام 2011 مخلفة ورائها صدمات اقتصادية متعددة، كانت أكثرها وطأة خسائر ثلاثة أرباع عائدات النفط التي كانت تمثل أكثر من نصف إيرادات الحكومة السودانية و95% من صادراتها، ليهبط معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير، ويرتفع التضخم لمستوى الرقمين، مع ارتفاع مضطرد في أسعار الوقود، ليؤدي كل ذلك المزيج إلى اندلاع احتجاجات عنيفة عام 2013 قابلها قوات أمنية سودانية بحملات قمع وقتل وسجن للمحتجين، وهو مشهد لا تختلف بداياته عن الحادث الآن كثيرًا. ورغم أن انفصال الجنوب، وما صاحبه من نزع لآبار النفط المتخمة وفشل خطط تقاسم الأرباح التي اتفق عليها الطرفان نظير السماح بمرور النفط الجنوبي في خطوط النقل الواقعة في الشمال بسبب اندلاع الحرب الأهلية جنوبًا، رغم أن ذلك كله يبدو على ظاهره السبب الرئيس في التدهور الاقتصادي الذي تلى عملية الانفصال وحتى الآن، إلا أن أحد أسباب التدهور الرئيسة ربما في حقيقته ربما يختلف عن تلك الصورة المباشرة.
بالتزامن مع اتفاق السلام الشامل عام 2005، وحتى تقرير المصير بانفصال جنوب السودان بعدها بـ ست سنوات، كانت تلك الفترة ممثلة لذروة الإنتاج النفطي السوداني مع تدفقات نقدية دولارية قدرت بالمليارات، وتمكنت تلك الطفرة النفطية بالفعل من تحفيز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7.9% بين عامي 2004 و2008، مما سمح بتغطية ثغرة كبيرة في ذلك النمو، وعن غياب تلك الطفرة عقب الانفصال الفعلي، تُرك الاقتصاد السوداني عاريًا لتظهر حقيقة الهشاشة والضعف الاقتصادي على إثر فخ ما يسميه الاقتصاديين بـ “المرض الهولندي Dutch Disease“، حيث أدت التدفقات الدولارية الضخمة في فترة الطفرة إلى ارتفاع قيمة العملة السودانية أمام الدولار، وبالتالي ارتفاع تكاليف الصادرات السودانية غير النفطية ومن ثم عدم قدرتها على المنافسة العالمية مع ارتفاع قيمة الواردات، مما أدى إلى تدهور الصناعات المحلية غير النفطية نتيجة لعدم قدرتها على المنافسة، ليصبح اعتماد الاقتصاد الرئيس على عائدات النفط فقط بلا أي بديل.
كان من المتوقع أن تبدأ الحكومة في خطة تنويع الاقتصاد عقب اتفاق عام 2005 والاستجابة للتوصيات القادمة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي بضرورة إجراء ذلك التنويع، واستغلال الوفورات الدولارية المتدفقة في بناء قاعدة إنتاجية قوية، من خلال تطوير الصناعات التحويلية وتنمية القطاع الزراعي والحيواني والإنفاق على التنمية الاجتماعية والبشرية، ليسهل بعد ذلك عملية فطم الاقتصاد عن النفط، والاعتماد على تدفقات نقدية غير نفطية، إلا أن ما حدث وحتى الانفصال كان خلاف كل ذلك.
إذن كان ذلك السبب الرئيس لاشتعال شرارة الأزمة الاقتصادية المستمرة، حيث اكتفت النخبة السودانية الحاكمة بعائدات النفط مع إهمال كبير للصناعات التحويلية والزراعية، لتجد نفسها بعد جفاف مصدر تلك العائدات؛ بصدد اقتصاد مهترئ لا يقوى على مواجهة التحديات الناجمة عن الانفصال، على الرغم من علم تلك النخبة باحتمالية الانفصال الكبيرة قبل حدوثه بـ 6 سنوات عند توقيع اتفاق السلام، ولم تفاجأ به على الأرجح في يناير/كانون الثاني لعام الربيع العربي حينما صوت الجنوبيون على الانفصال باكتساح.
ونتيجة للإهمال الحكومي على مدار سنوات الطفرة في بناء قاعدة إنتاجية قوية، ظهرت مشكلة أخرى ضاغطة لاسيما في العامين الماضيين وهي عجز الميزان التجاري نتيجة ارتفاع معدل الواردات بما في ذلك السلع الغذائية، رغم امتلاك البلد الإفريقي الغني طبيعيًا لـ 50 مليون فدان صالحة للزراعة يشقها أطول أنهار العالم، وجاء ذلك الارتفاع مقابل انخفاض الصادرات، إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي -الواردة في تقرير المفوضية الأوروبية لوضع التجارة مع السودان- إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري السوداني إلى 3.7 مليار دولار خلال العام الماضي 2017(6)، ليضغط ذلك العجز على الاحتياطي الدولاري الشحيح بطبيعة الحال بعد انتهاء عصر النفط، وليؤدي لمرحلة الانهيار الحتمية.
مع اقتصاد جائع للعملة الصعبة، وصعوبة تمويل الواردات لاسيما الأساسية منها، وجد نظام البشير نفسه أمام مسارين اثنين: فإما الاقتراض بشراهة وبلا توقف، أو تخفيض قيمة العملة، وكان أيًا من المسارين كفيلًا بتركيع أي اقتصاد ناشئ، إلا أن البنك المركزي السوداني، والذي لا يمتلك أي بدائل بطبيعة الحال، قرر اتخاذ المسارين معًا، فقام باقتراض 200 مليون دولار من ثلاثة بنوك من أجل تمويل استيراد المنتجات البترولية والقمح والأدوية(7)، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول المنصرم قرر للمرة الثالثة في بضعة أشهر خفض قيمة الجنيه السوداني المتداول في البنوك التجارية بنسبة 60%، لينخفض رسميًا من 29 إلى 47.5 جنيه لكل دولار(8)، مع استمرار فرض القيود على سحب السيولة، ووسط هجوم ضارٍ من قبل السوق السوداء على قيمة الجنيه مع نمو حجم تلك السوق، وهو نمو فاق المألوف حتى أن الحكومة السودانية نفسها صارت ضمن عملاء السوق السوداء.
يمكن لسعر الدولار الأميركي أن يوضح مدى تسارع عجلة الاقتصاد السوداني المنهار، فقبل بضع سنوات فقط، ورغم وطأة العقوبات الأميركية المتواصلة وقتها، كان الدولار مساويًا لما قيمته أقل من أربعة جنيهات سودانية، وهو سعر صرف تدهور بشدة ليبلغ الآن “رسميًا” 47.5 جنيه لكل دولار، بينما تخطى في السوق السوداء أكثر من 63 جنيه لكل دولار، وسط أزمة ندرة غير مسبوقة في حجم السيولة النقدية وخلو أجهزة الصراف الآلي من الأموال، حتى أصبح مشهد الصفوف الطويلة أمام البنوك التجارية مألوفًا في أنحاء الخرطوم خلال الأسابيع الماضية.
دفعت تلك الأزمة البنك المركزي لبدء طباعة عملة فئة 100 جنيه، للمرة الأولى، بعد أن نهش التضخم القوة الشرائية للعملة فئة الـ 50 جنيهًا، ليرتفع التضخم لأكثر من 68%، وهو أعلى معدل تضخم في السودان منذ عقدين ومن أعلى المعدلات العالمية(3). ورفقة ذلك، ورغم المعدل القياسي؛ لم ترتفع الرواتب بوتيرة مناسبة وموازية تقلل من تأثير ذلك الارتفاع، ما أدى لانتشار غضب وعدم رضا شعبي بين السودانيين الذين يعانون من نقص في الدواء والغذاء في دولة لطالما عرفت قديمًا بأنها إحدى سلال غذاء العالم، حتى اضطرت العديد من الأسر الفقيرة لإلغاء وجبات كاملة يومية ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، ثم تطور الأمر بالبعض للجوء للعنف لتوفير الغذاء، قبل أن تنفجر الأوضاع كما هي عليه الآن.
في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي أصدر الجهاز المركزي السوداني للإحصاء نتائج مسحه للفقر بين عامي 2014-2015، لتخرج النتيجة بأن معدلات الفقر في البلاد قد وصلت لـ 36%، ولأن الأمور بطبيعة الحال ساءت كثيرًا منذ ذلك الوقت، فقد أشار مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد MPI للعام الحالي 2018(4)، وهو مؤشر يقيس الفقر الحاد من خلال 10 مؤشرات فرعية ويصدر بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، أشار إلى استحواذ السودان على النسبة الأكبر من فقراء الدول العربية، موضحًا أن مجموع الفقراء في تلك الدول باختلاف مستوى الفقر يصل لحوالي 66 مليون فقير، تستحوذ السودان على قرابة ثلثهم أو نحو 20 مليونًا تقريبًا، ويعني ذلك بشكل أوضح أن نحو نصف سكان السودان فقراء باختلاف مستويات الفقر، وأن نسبة الفقر السودانية قد قفزت من 36% لـ 50% من التعداد السكاني على أقل تقدير.
علاوة على فقر نصف سكانها، لا تزال السودان دولة مثقلة بديون خارجية هائلة، وتبلغ ديون السودان الخارجية 56 مليار دولار منها 85% متأخرات، ومع تأخرها عن السداد فقد تراكمت عليها متأخرات كبيرة حتى تم إدراجها تحت قائمة “عدم الاستحقاق non-accrual status” لدى مجموعة البنك الدولي WBG منذ عام 1994، ما يعني عدم قدرتها على الاقتراض من مؤسسات البنك الدولي كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير والرابطة الدولية للتنمية، لذا يلجأ البنك الدولي في سبيل تمويل برنامج “الحد من الفقر المدقع” داخل السودان إلى الصناديق الاستئمانية لتنمية القدرات، والشراكات المختلفة، وميزانية البنك الدولي نفسها(5).
«عندما تبدأ بالاستثمار في بلد كهذا، فإنه أمر صعب، هذا هو الوضع الذي يمكنك أن تخسر فيه الكثير من الأموال»
“ماريا ستراتونوفا”، مديرة مشروع في مجموعة “الدويش”، ومقرها لندن، تقوم بتطوير وتشغيل مشاريع الطاقة ونقلها وتوزيعها في إفريقيا – متحدثة عن الاستثمار في السودان
رغم كل ما سبق، كان بإمكان النظام السوداني الخروج من تلك المعضلة عن طريق أحد أهم مصادر التدفق النقدي الأخرى وهي “الاستثمار الأجنبي المباشر”، وهو مصدر يمكنه صب الدولارات التي يحتاجها الاقتصاد السوداني، وعقب رفع العقوبات الأميركية منذ عام وينيف، قام وزير الدولة السابق للاستثمار “أسامة فيصل” بجولات دولية كبيرة من ألمانيا إلى البحرين لجذب اهتمام المستثمرين، مستهدفًا 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا، وعارضًا الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الزراعة والطاقة والتعدين(9)، وبغض النظر عن حجم الرقم الذي استهدفه الوزير وقتها، إلا أن الأمر لم يكن بتلك البساطة، فأثناء توقف “فيصل” في لندن أثناء جولته الترويجية للاستثمار، أصر المستثمرون الذين أظهروا بعض الاهتمام على أنهم سيطلبون ضمانات حكومية ليكونوا قادرين على إعادة الأموال إلى بلدانهم بحرية، لذا كان على “فيصل” العودة مباشرة للسودان لنقل رسالة مختصرة لرأس النظام مفادها: إصلاح بيئة الأعمال أولًا قبل التعويل على مجرد الزيارات الخارجية، وهو درس ربما لم تتعلمه النخب الحاكمة السودانية حتى الآن.
تقبع السودان في أحد أسوأ مراكز ممارسة أنشطة الأعمال على المستويين الإفريقي والعالمي، لذا لم يكن مستغربًا انحسار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العامين الماضيين بشدة. ويتضح ذلك بالنظر إلى وضع السودان في أحد أهم بوصلات المستثمرين “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018” والصادر عن البنك الدولي، وهو تقرير يقيس 11 إجراءً من الإجراءات الحكومية في حياة الشركات لتحديد مدى سهولة ممارسة الأعمال، لنجد أن السودان تقبع في المرتبة 170 من أصل 190 دولة حول العالم في مدى ملائمة بيئة العمل للاستثمار، أي أنها تبتعد عن القاع بـ 19 مركز فقط(10)، وتتأخر عنها فقط مجموعة من أفقر الدول على سطح الأرض.
بمزيد من التدقيق في التقرير يتبين أن دعوات النظام السوداني وحكومته لجذب الاستثمار الأجنبي إلى السودان منذ العام الماضي، لا تخرج على الأرجح عن كونها أصوات دعائية فقط. فعند مطالعة الإصلاحات التي تم تنفيذها لتسهيل القيام بالأعمال التجارية العام الماضي، يفاجئنا التقرير بقيام السودان بتنفيذ إجراءين اثنين جعلا ممارسة الأعمال أكثر صعوبة، أحدهما في جانب بدء النشاط التجاري، حيث جعلت زيادة تكلفة “ختم الشركة” بدء الأعمال أكثر صعوبة بمراحل، وآخر في جانب حماية المستثمرين الأقليات، عن طريق السماح بمقاضاة المديرين في حالة المعاملات الضارة، وتناقص حقوق ودور المساهمين في القرارات الرئيسة للشركات وتقويض هياكل الملكية والتحكم، مقابل صفر إصلاحات لتسهيل الأعمال بشكل فعال على الأراضي السودانية.
لم يتوقف الأمر عند الاستثمارات الخاصة، وإنما طال الاتفاقيات الاستثمارية التي تجري على مستوى الرؤساء، ففي ديسمبر/كانون الأول للعام الماضي أيضًا قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة للسودان، وهي أول زيارة لرئيس تركي، حيث تم التوقيع على 12 اتفاقية ثنائية بين الرئيسين التركي والبشير، اتفاقيات تغطي القطاعات الزراعية والاقتصادية والعسكرية والأمنية(11)، إلا أنه وبعد مرور ستة أشهر على توقيع تلك الاتفاقيات، بدا أن مصيرها الفشل حينما أدانت أنقرة العقبات البيروقراطية لدى السودان والتي تقف حائلًا كبيرًا دون تنفيذ تلك الاتفاقيات، وفقًا لموقع “أفريكا إنتلجنس”(12)، ما دفع الحكومة بعدها للقول بأنها تعتزم مراجعة وإصلاح منظومة الاستثمار الأجنبي لإدخال العملة الأجنبية.(13)
إذن، بدا وكأن انتظار استثمارات أجنبية فعالة ومنتظمة على الأراضي السودانية الواعدة طبيعيًا هو بمثابة انتظار لجودو في ظل بيروقراطية وعوائق نظام البشير ونخبته، وهي بيروقراطية تبدو أشبه بسلاح أعمى لا يفرق بين عدو وحليف، ويقف حاجزًا أمام الجميع تقريبًا، لكن البيروقراطية والعوائق الإدارية والفقر التخطيطي لم يكونوا أبدًا هم العدو الأول، وإنما يحتل المرتبة الأولى دومًا عدو من نوع تقليدي ومألوف في كامل الرقعة العربية بلا استثناء.
في إبريل/نيسان للعام الحالي شن “البشير” -من خلال العديد من الخطابات “النارية”- ما أطلق عليه «حرب ضد الفساد» لإنعاش الاقتصاد المتعثر، ومع تقليدية الشعار العربي الرسمي الأزلي، كان متوقعًا وبديهيًا أن يكون ذراعه في تلك المعركة هو جهازه الأكثر قربًا ووفاءً “جهاز الأمن والمخابرات الوطني”. حينها، اتهم النظام السوداني -ومازال- تجار العملات الأجنبية والمصرفيين والمهربين تحديدًا بأنهم أضروا بالاقتصاد(14)، وبالتزامن مع ذلك تم اعتقال نحو 16 من رجال الأعمال الكبار وثلاثة ضباط أمن ومصرفيين كبار أيضًا.
تحتل السودان المرتبة الثالثة في إفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب إفريقيا وغانا، وهو المورد الذي تعتمد عليه الحكومة في سد عجز النقد الأجنبي قدر الاستطاعة، غير أن الحدود السودانية شبه المثقوبة أمنيًا، علاوة على سياسات المركزي السوداني الخاطئة، قد ساعدا على ازدهار عمليات تهريب الذهب بكميات ضخمة، فقد بلغ الإنتاج السوداني خلال النصف الأول من العام الحالي 63.3 طن ذهب، بينما بلغ المفقود منه حوالي 48.8 طنًا وفقًا لتقرير وزارة المعادن السودانية(15)، بنسبة تتجاوز الـ 77% من الناتج المحلي.
ورغم ثراء البلاد بالمعدن النفيس، فإن المركزي السوداني لا يزال يصر على شراء الذهب وفق سعر الدولار الرسمي غير الحقيقي تبعًا لوضع السوق، ومن ثم يفضل المنتجون تهريبه للخارج للاستفادة من سعر الدولار المرتفع وارتفاع الطلب الخارجي، مما يؤدي دومًا لحرمان الخزانة العامة السودانية من مئات الملايين من الدولارات.
بجانب الذهب، تبع البشير حملته بإنشاء محكمة مختصة بقضايا الفساد لأول مرة في البلاد، إلا أنه من غير الواضح ما إن كانت المحكمة على استعداد للتحقيق في قضايا تخص النخبة الحاكمة، وربما رأس الدولة نفسه إن لزم الأمر، إذ تشير وثائق سرية نشرها موقع ويكيليكس -في ديسمبر/كانون الأول عام 2010(16)– حول محادثات تمت بين “لويس أوكامبو”، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، والسفيرة الأميركية للأمم المتحدة وقتها “سوزان رايس”، والسفير الأمريكي “أليخاندرو ووالف” في مارس/آذار عام 2009، أي بعد وقت قصير من صدور مذكرة توقيف دولية بحق البشير تتهمه بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، أشارت إلى «استيلاء رجال في السلطة على تسعة مليارات دولار من أموال النفط السودانية وإيداعها في بنوك لندن».
لكنه وبغض النظر عن صحة تلك المزاعم، فإن السودان، ووفقًا لتقرير الفساد الصادر عن شركة “غان” للأبحاث، تعتبر واحدة من أكثر الدول «فسادًا» في العالم، ومن المعروف أن الموظفين العموميين يطالبون برشى لتقديم الخدمات التي يحق للأفراد والشركات الحصول عليها قانونًا بشكل مجاني، ويملك المسؤولون الحكوميون حصصًا مباشرة وغير مباشرة في العديد من الشركات، وكثيرًا ما يشاركون أيضًا في ممارسات فاسدة دون عقاب(17). ويؤكد مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي 2017، والذي يقيس مستويات الفساد في القطاع العام، تلك الحقيقة، حيث تجلس السودان في قاع التصنيف تقريبًا لتحتل المرتبة 175 من أصل 180 دولة حول العالم(18).
إذن ومن هنا فقط يمكننا تفسير كيف تمكنت مستشفى “يونيفرسال” التابعة للأجهزة الأمنية السودانية من الحصول على أحدث الأجهزة الطبية بخلاف المستشفيات الحكومية الفارغة. وبالبحث قليلًا يتضح أن المستشفيات التابعة للنخبة الحاكمة في السودان هي التي تتمكن من التزود بالمعدات الحديثة والأدوية ومن ثم تقديم الخدمات الطبية بتكاليف باهظة.
يعد القطاع الطبي واحدًا من القطاعات التي تهيمن عليها النخبة الحاكمة من خلال العديد من المستشفيات الخاصة المنتشرة في العاصمة الخرطوم، والتي يملكها أفراد من الجيش والشرطة والأمن القومي وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، مستفيدين من نقص الخدمات الصحية وعجز المستشفيات الحكومية عن التزود بالمعدات إما لنقص الأموال أو لصعوبات استيراد الأجهزة بسبب العقوبات المرفوعة حديثًا، ومن ثم تحقيق أرباح خيالية على مر السنوات السابقة وترسيخ سيطرتها على القطاع.
يأتي مستشفى الزيتونة التخصصي كأحد أوضح الأمثلة على ذلك، وهو مستشفى مجهز بأحدث المعدات اليابانية والسويسرية في الخرطوم، ويملكه وزير الصحة مأمون حميدة، حيث تتعاقد الزيتونة مع المستشفيات الحكومية العامة القريبة المفتقرة إلى الأجهزة المطلوبة من أجل تقديم الخدمات التشخيصية بمقابل، ومن ثم وعلى ما يبدو فإن وزير الصحة قد يستفيد بشكل شبه مباشر من تدهور الأوضاع الصحية العامة في السودان.
ويبدو أن صناعة تلك الحالة يعود بالأساس إلى العقوبات الأميركية التي استمرت لعقدين وحتى نهاية العام الماضي، فبعد سنوات طويلة من العزلة الاقتصادية سُمح للسودان بالانضمام إلى دائرة الاقتصاد العالمي حينما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أنها ستنهي العقوبات الأميركية، وهي عقوبات كان يفترض بها رسميًا أن تنجح في معاقبة وعزل النخبة الحاكمة التي كانت مسؤولة عن «انتهاكات حقوق الإنسان» بحسب الاتهامات الدولية، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا.
لم تكن منظومة العقوبات الأميركية على السودان على الأرجح بدعًا من العقوبات الأميركية المفروضة على البلدان الأخرى فيما يتعلق بإخفاقها في تهميش وعزل من هم في السلطة بالفعل، وإنما على العكس فإنها تساهم في ترسيخ أنظمتهم الأمنية مقابل التسبب في مصاعب اقتصادية هائلة للشعوب، ولم يكن السودانيين استثناءً من ذلك، فقد استهدفت العقوبات العديد من المؤسسات والوكالات الحكومية التي تقدم خدمات عامة أساسية للمواطنين مثل مؤسسة السكك الحديدية، والمؤسسة الوطنية للكهرباء، وشركة قطن السودان وغيرها، وأدى ذلك إلى لجوء أعضاء الحزب الحاكم والجهاز الأمني السودانيين لتأسيس شركات خاصة للمناورة والالتفاف حول العقوبات.
وباعتبارهم النخبة الحاكمة، فقد امتلكت تلك الشركات أفضلية مطلقة في الوصول للدولار الشحيح مع إعفاءات ضريبية ضخمة، فضلًا عن الحصول على عقود حكومية حصرية ومستمرة لتنفيذ مشروعات أو تقديم خدمات منها وإليها، ومن ثم تسببت تلك المنظومة في خنق الشركات المتوسطة والصغيرة التي تكافح للاستمرار وسط ذلك النفوذ الأمني، لينتهي الأمر إلى نتيجة حتمية: اتساع الفوارق في الدخول وسقوط المزيد من السودانيين في دائرة الفقر.
في نهاية المطاف، رسخت دوائر النفوذ المنتفعة سيطرتها الكاملة على كل منافذ الاقتصاد السوداني القليلة تاركين الفتات -والذي تحول للاشيء تقريبًا- للسودانيين أنفسهم، وفي ظل موجة الاحتجاجات الجديدة، والأعنف منذ فترة، والمطالبة بتغيير جذري، فإن تجارب سابقة ربما ينبغي أن توضع في الحسبان حين النظر لذلك الحراك، حيث نجا أرباب الفساد من احتجاجات شبيهة على مر الأعوام، إلا أن المؤكد في الأمر، وبغض النظر عن انتهاء ما يحدث بتغييرات شاملة أو محدودة، فإن الاقتصاد السوداني بعقوبات أو بدونها قد أصبح يحتاج بالضرورة لما يشبه قبلة حياة عاجلة، وإصلاحات طويلة الأجل وفاعلة تحاول إنقاذ سودان ما بعد الانفصال من سقوط في هوة تردٍ معيشي عميقة مازال مستمرًا بلا نهاية.
الجزيرة الاخبارية